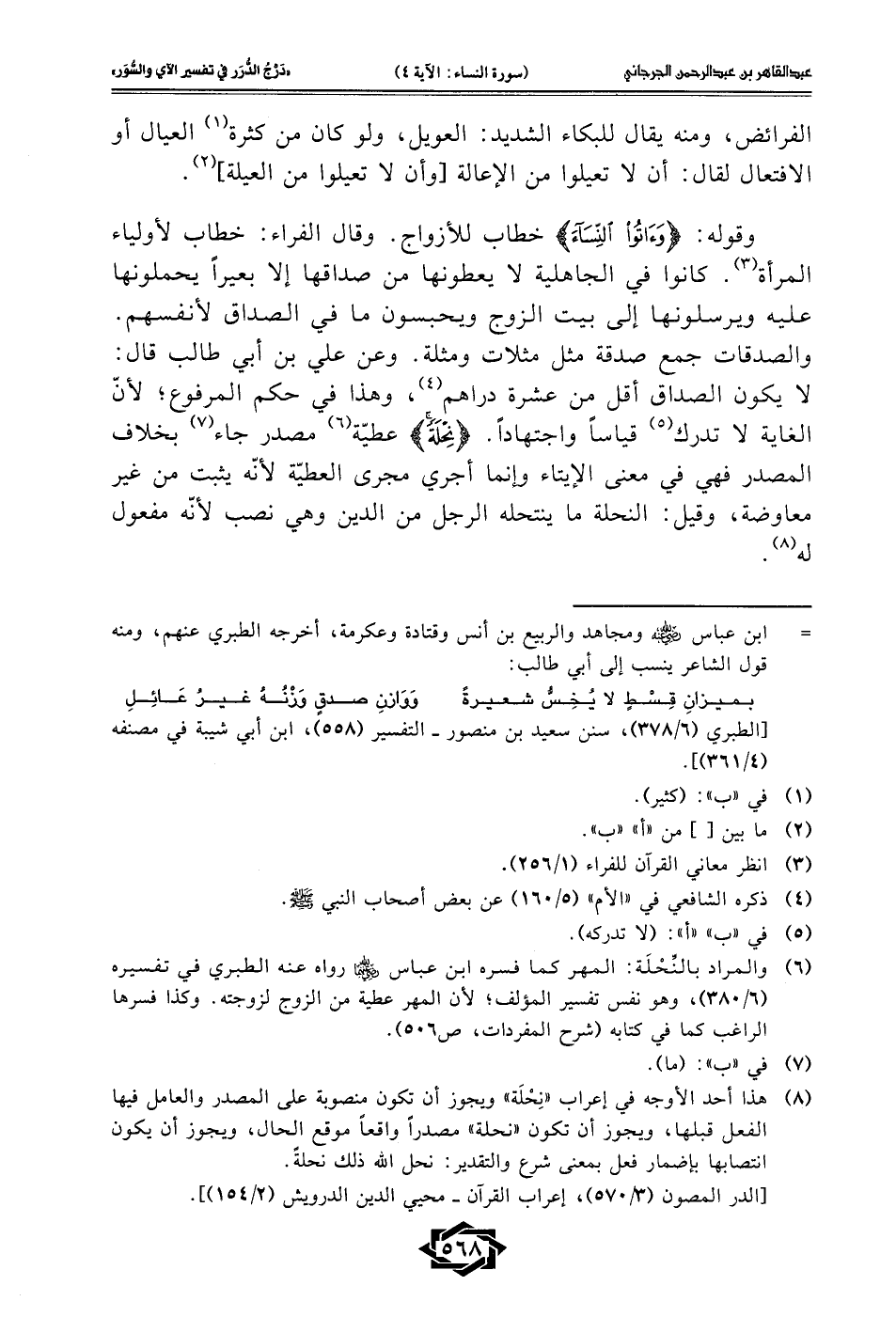
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 2)
الفرائض، ومنه يقال للبكاء الشديد: العويل، ولو كان من كثرة (¬1) العيال أو الافتعال لقال: أن لا تعيلوا من الإعالة [وأن لا تعيلوا من العيلة] (¬2).وقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ} خطاب للأزواج. وقال الفراء: خطاب لأولياء المرأة (¬3). كانوا في الجاهلية لا يعطونها من صداقها إلا بعيرًا يحملونها عليه ويرسلونها إلى بيت الزوج ويحبسون ما في الصداق لأنفسهم. والصدقات جمع صدقة مثل مثلات ومثلة. وعن علي بن أبي طالب قال: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم (¬4)، وهذا في حكم المرفوع؛ لأنّ الغاية لا تدرك (¬5) قياسًا واجتهادًا. {نِحْلَةً} عطيّة (¬6) مصدر جاء (¬7) بخلاف المصدر فهي في معنى الإيتاء وإنما أجري مجرى العطيّة لأنّه يثبت من غير معاوضة، وقيل: النحلة ما ينتحله الرجل من الدين وهي نصب لأنّه مفعول له (¬8).
¬__________
= ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة وعكرمة، أخرجه الطبري عنهم، ومنه قول الشاعر ينسب إلى أبي طالب:
بميزانِ قِسْطٍ لا يُخِسُّ شعيرةً ... وَوَازنِ صدقٍ وَزْنُهُ غيرُ عَائِلِ
[الطبري (6/ 378)، سنن سعيد بن منصور - التفسير (558)، ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 361)].
(¬1) في "ب": (كثير).
(¬2) ما بين [...] من "أ" "ب".
(¬3) انظر معاني القرآن للفراء (1/ 256).
(¬4) ذكره الشافعي في "الأم" (5/ 160) عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) في "ب" "أ": (لا تدركه).
(¬6) والمراد بالنِّحْلَة: المهر كما فسره ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه عنه الطبري في تفسيره (6/ 380)، وهو نفس نفسير المؤلف؛ لأن المهر عطية من الزوج لزوجته. وكذا فسرها الراغب كما في كتابه (شرح المفردات، ص 506).
(¬7) في "ب": (ما).
(¬8) هذا أحد الأوجه في إعراب "نِحْلَة" ويجوز أن تكون منصوبة على المصدر والعامل فيها الفعل قبلها، ويجوز أن تكون "نحلة" مصدرًا واقعًا موقع الحال، ويجوز أن يكون انتصابها بإضمار فعل بمعنى شرع والتقدير: نحل الله ذلك نحلةً.
[الدر المصون (3/ 570)، إعراب القرآن - محيي الدين الدرويش (2/ 154)].