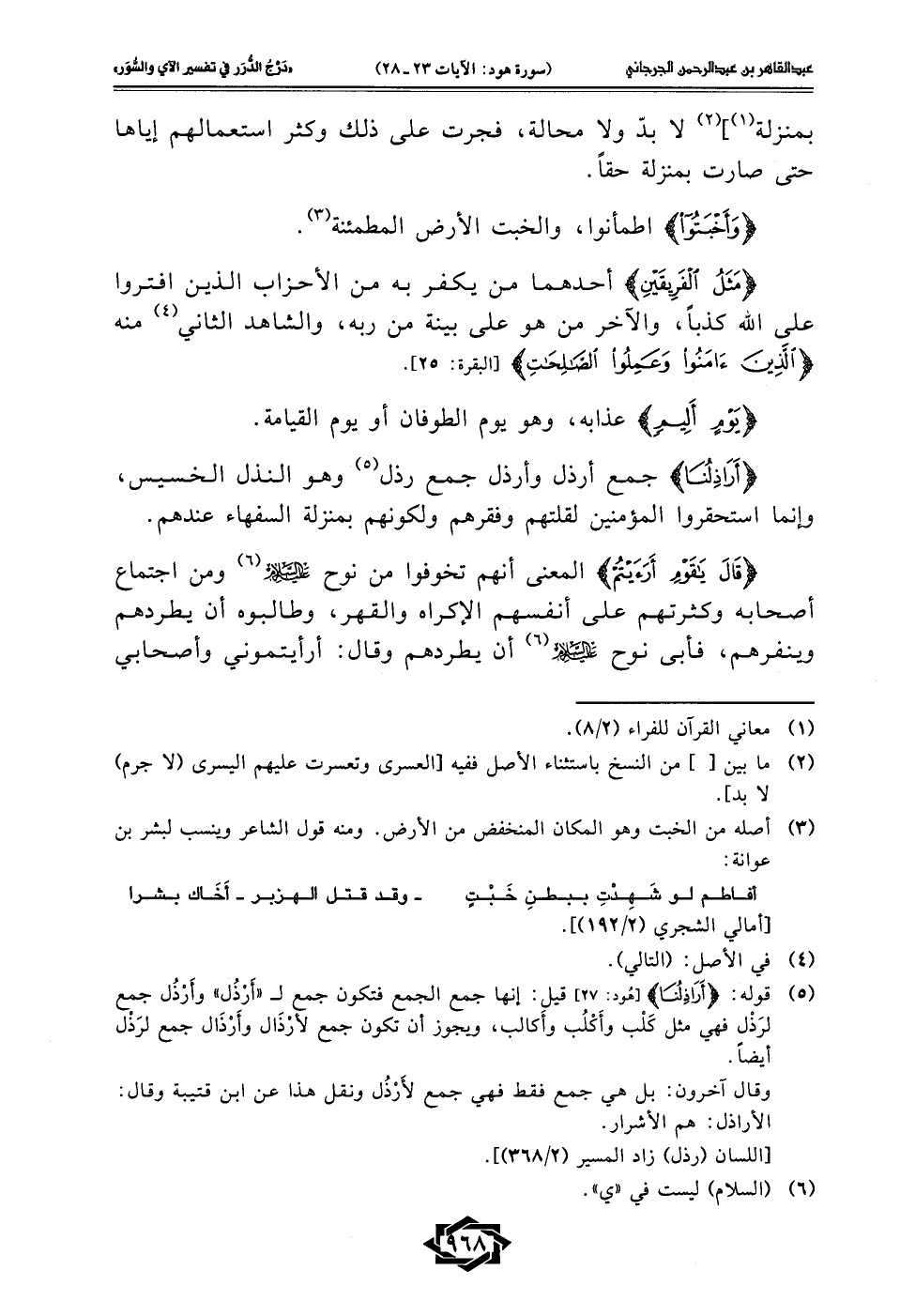
كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (اسم الجزء: 3)
بمنزلة (¬1)] (¬2) لا بدّ ولا محالة، فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقًا.{وَأَخْبَتُوا} اطمأنوا، والخبت الأرض المطمئنة (¬3).
{مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ} أحدهما من يكفر به من الأحزاب الذين افتروا علي الله كذبًا، والآخر من هو على بينة من ربه، والشاهد الثاني (¬4) منه {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25].
{يَوْمٍ أَلِيمٍ} عذابه، وهو يوم الطوفان أو يوم القيامة.
{أَرَاذِلُنَا} جمع أرذل وأرذل جمع رذل (¬5) وهو النذل الخسيس، وإنما استحقروا المؤمنين لقلتهم وفقرهم ولكونهم بمنزلة السفهاء عندهم.
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ} المعنى أنهم تخوفوا من نوح -عليه السلام- (¬6) ومن اجتماع أصحابه وكثرتهم على أنفسهم الإكراه والقهر، وطالبوه أن يطردهم وينفرهم، فأبى نوح -عليه السلام- (6) أن يطردهم وقال: أرأيتموني وأصحابي
¬__________
(¬1) معاني القرآن للفراء (2/ 8).
(¬2) ما بين [...] من النسخ باستثناء الأصل ففيه [العسرى وتعسرت عليهم اليسرى (لا جرم) لا بد].
(¬3) أصله من الخبت وهو المكان المنخفض من الأرض. ومنه قول الشاعر وينسب لبشر بن عوانة:
أفاطم لو شَهِدْتِ ببطنِ خَبْتٍ ... - وقد قتل الهزبر- أَخَاك بشرا
[أمالي الشجري (2/ 192)].
(¬4) في الأصل: (التالي).
(¬5) قوله: {أَرَاذِلُنَا} [هُود: 27] قيلِ: إنها جمع الجمع فتكون جمع لـ "أَرْذُل" وأَرْذُل جمع لرَذْل فهي مثل كَلْب وأَكْلُب وأَكالب، ويجوز أن تكون جمع لأرْذَال وأَرْذَال جمع لرَذْل أيضًا.
وقال آخرون: بل هي جمع فقط فهي جمع لأَرْذُل ونقل هذا عن ابن قتيبة وقال: الأراذل: هم الأشرار.
[اللسان (رذل) زاد المسير (2/ 368)].
(¬6) (السلام) ليست في "ي".