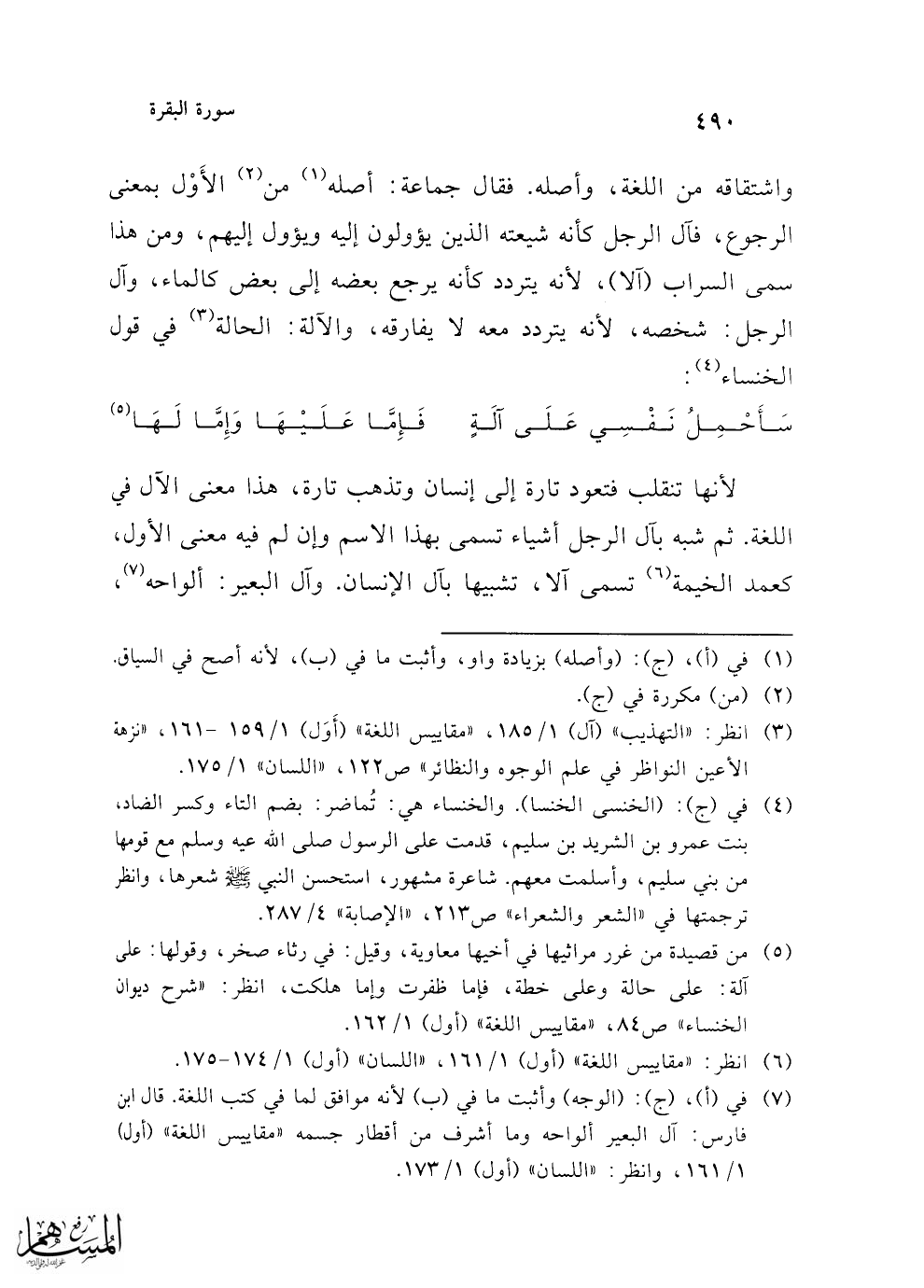
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 2)
واشتقاقه من اللغة، وأصله. فقال جماعة: أصله (¬1) من (¬2) الأَوْل بمعنى الرجوع، فال الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه ويؤول إليهم، ومن هذا سمى السراب (آلا)، لأنه يتردد كأنه يرجع بعضه إلى بعض كالماء، وآل الرجل: شخصه، لأنه يتردد معه لا يفارقه، والآلة: الحالة (¬3) في قول الخنساء (¬4):سأَحْمِلُ نَفْسِي عَلَى آلَةٍ ... فَإِمَّا عَلَيْهَا وَإِمَّا لَهَا (¬5)
لأنها تنقلب فتعود تارة إلى إنسان وتذهب تارة، هذا معنى الآل في اللغة. ثم شبه بآل الرجل أشياء تسمى بهذا الاسم وإن لم فيه معنى الأول، كعمد الخيمة (¬6) تسمى آلا، تشبيها بآل الإنسان. وآل البعير: ألواحه (¬7)،
¬__________
(¬1) في (أ)، (ج): (وأصله) بزيادة واو، وأثبت ما في (ب)، لأنه أصح في السياق.
(¬2) (من) مكررة في (ج).
(¬3) انظر: "التهذيب" (آل) 1/ 185، "مقاييس اللغة" (أَوَل) 1/ 159 - 161، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" ص 122، "اللسان" 1/ 175.
(¬4) في (ج): (الخنسى الخنسا). والخنساء هي: تُماضر: بضم التاء وكسر الضاد، بنت عمرو بن الشريد بن سليم، قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم، وأسلمت معهم. شاعرة مشهور، استحسن النبي - صلى الله عليه وسلم - شعرها، وانظر ترجمتها في "الشعر والشعراء" ص213، "الإصابة" 4/ 287.
(¬5) من قصيدة من غرر مراثيها في أخيها معاوية، وقيل: في رثاء صخر، وقولها: على آلة: على حالة وعلى خطة، فإما ظفرت وإما هلكت، انظر: "شرح ديوان الخنساء" ص 84، "مقاييس اللغة" (أول) 1/ 162.
(¬6) انظر: "مقاييس اللغة" (أول) 1/ 161، "اللسان" (أول) 1/ 174 - 175.
(¬7) في (أ)، (ج): (الوجه) وأثبت ما في (ب) لأنه موافق لما في كتب اللغة. قال ابن فارس: آل البعير ألواحه وما أشرف من أقطار جسمه "مقاييس اللغة" (أول) 1/ 161، وانظر: "اللسان" (أول) 1/ 173.