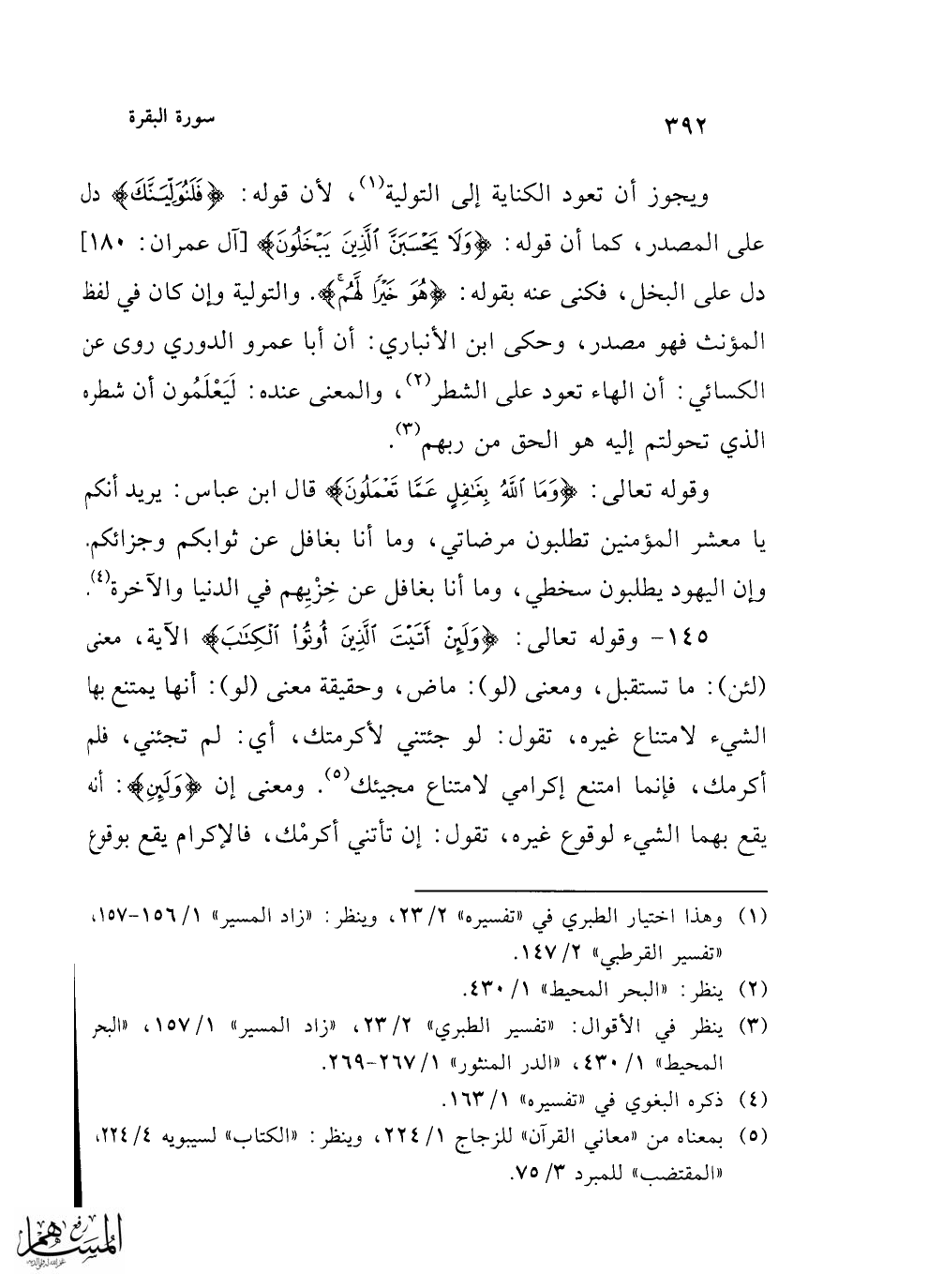
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 3)
ويجوز أن تعود الكناية إلى التولية (¬1)، لأن قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ} دل على المصدر، كما أن قوله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} [آل عمران: 180] دل على البخل، فكنى عنه بقوله: {هُوَ خَيْرًا لَهُمْ}. والتولية وإن كان في لفظ المؤنث فهو مصدر، وحكى ابن الأنباري: أن أبا عمرو الدوري روى عن الكسائي: أن الهاء تعود على الشطر (¬2)، والمعنى عنده: لَيَعْلَمُون أن شطره الذي تحولتم إليه هو الحق من ربهم (¬3).وقوله تعالى: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} قال ابن عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي، وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. وإن اليهود يطلبون سخطي، وما أنا بغافل عن خِزْيِهم في الدنيا والآخرة (¬4)،
145 - وقوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية، معنى (لئن): ما تستقبل، ومعنى (لو): ماض، وحقيقة معنى (لو): أنها يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، تقول: لو جئتني لأكرمتك، أي: لم تجئني، فلم أكرمك، فإنما امتنع إكرامي لامتناع مجيئك (¬5). ومعنى إن {وَلَئِنْ}: أنه يقع بهما الشيء لوقوع غيره، تقول: إن تأتني أكرمْك، فالإكرام يقع بوقوع
¬__________
(¬1) وهذا اختيار الطبري في "تفسيره" 2/ 23، وينظر: "زاد المسير" 1/ 156 - 157، "تفسير القرطبي" 2/ 147.
(¬2) ينظر: "البحر المحيط" 1/ 430.
(¬3) ينظر في الأقوال: "تفسير الطبري" 2/ 23، "زاد المسير" 1/ 157، "البحر المحيط" 1/ 430، "الدر المنثور" 1/ 267 - 269.
(¬4) ذكره البغوي في "تفسيره" 1/ 163.
(¬5) بمعناه من "معاني القرآن" للزجاج 1/ 224، وينظر: "الكتاب" لسيبويه 4/ 224, "المقتضب" للمبرد 3/ 75.