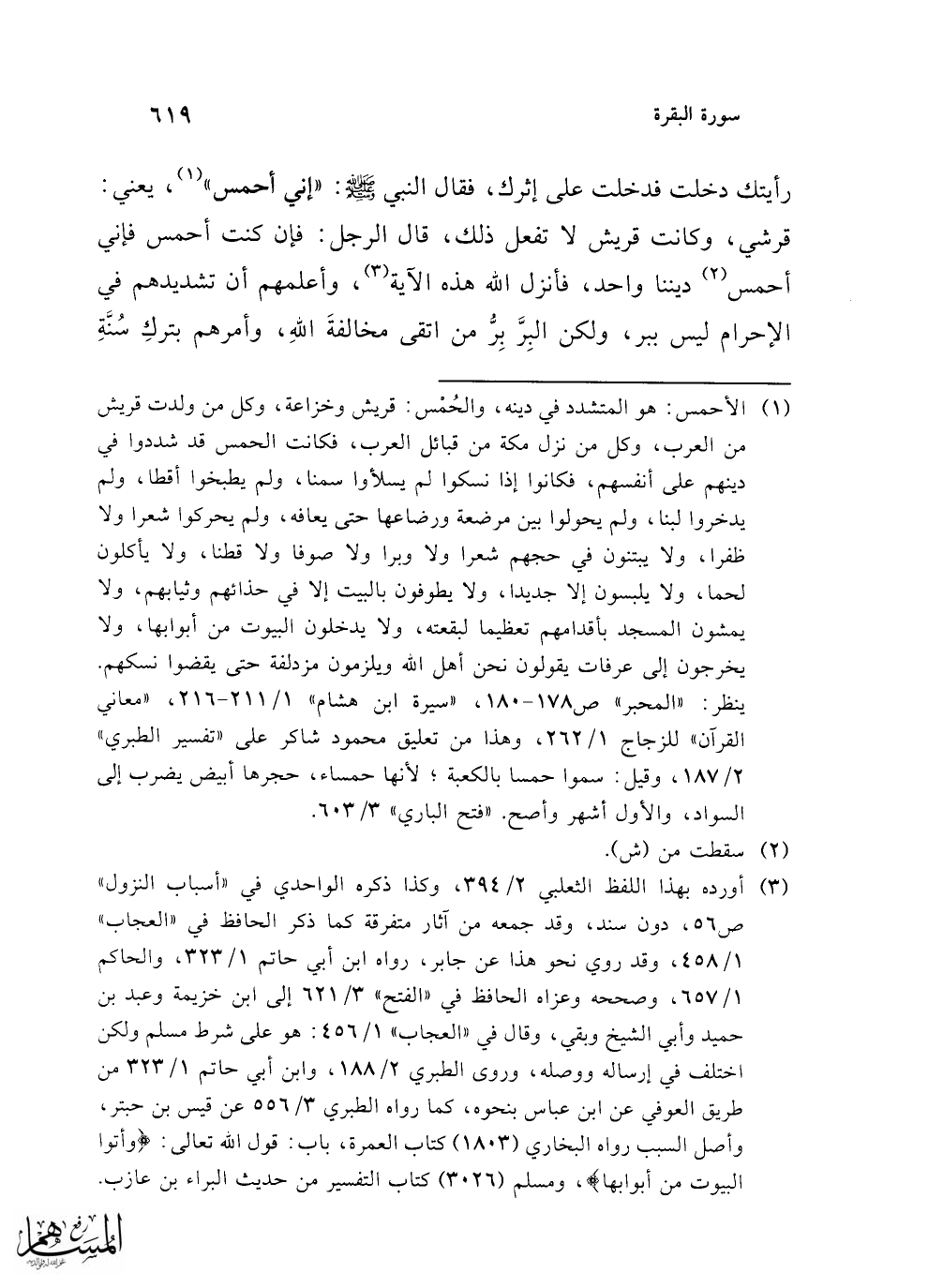
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 3)
رأيتك دخلت فدخلت على إثرك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أحمس" (¬1)، يعني: قرشي، وكانت قريش لا تفعل ذلك، قال الرجل: فإن كنت أحمس فإني أحمس (¬2) ديننا واحد، فأنزل الله هذه الآية (¬3)، وأعلمهم أن تشديدهم في الإحرام ليس ببر، ولكن البِرَّ بِرُّ من اتقى مخالفةَ اللهِ، وأمرهم بتركِ سُنَّةِ¬__________
(¬1) الأحمس: هو المتشدد في دينه، والحُمْس: قريش وخزاعة، وكل من ولدت قريش من العرب، وكل من نزل مكة من قبائل العرب، فكانت الحمس قد شددوا في دينهم على أنفسهم، فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمنا، ولم يطبخوا أقطا، ولم يدخروا لبنا، ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافه، ولم يحركوا شعرا ولا ظفرا، ولا يبتنون في حجهم شعرا ولا وبرا ولا صوفا ولا قطنا، ولا يأكلون لحما، ولا يلبسون إلا جديدا، ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهم، ولا يمشون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعته، ولا يدخلون البيوت من أبوابها، ولا يخرجون إلى عرفات يقولون نحن أهل الله ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم. ينظر: "المحبر" ص178 - 180، "سيرة ابن هشام" 1/ 211 - 216، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 262، وهذا من تعليق محمود شاكر على "تفسير الطبري" 2/ 187، وقيل: سموا حمسا بالكعبة؛ لأنها حمساء، حجرها أبيض يضرب إلى السواد، والأول أشهر وأصح. "فتح الباري" 3/ 603.
(¬2) سقطت من (ش).
(¬3) أورده بهذا اللفظ الثعلبي 2/ 394، وكذا ذكره الواحدي في "أسباب النزول" ص 56، دون سند، وقد جمعه من آثار متفرقة كما ذكر الحافظ في "العجاب" 1/ 458، وقد روي نحو هذا عن جابر، رواه ابن أبي حاتم 1/ 323، والحاكم 1/ 657، وصححه وعزاه الحافظ في "الفتح" 3/ 621 إلى ابن خزيمة وعبد بن حميد وأبي الشيخ وبقي، وقال في "العجاب" 1/ 456: هو على شرط مسلم ولكن اختلف في إرساله ووصله، وروى الطبري 2/ 188، وابن أبي حاتم 1/ 323 من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه، كما رواه الطبري 3/ 556 عن قيس بن حبتر، وأصل السبب رواه البخاري (1803) كتاب العمرة، باب: قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}، ومسلم (3026) كتاب التفسير من حديث البراء بن عازب.