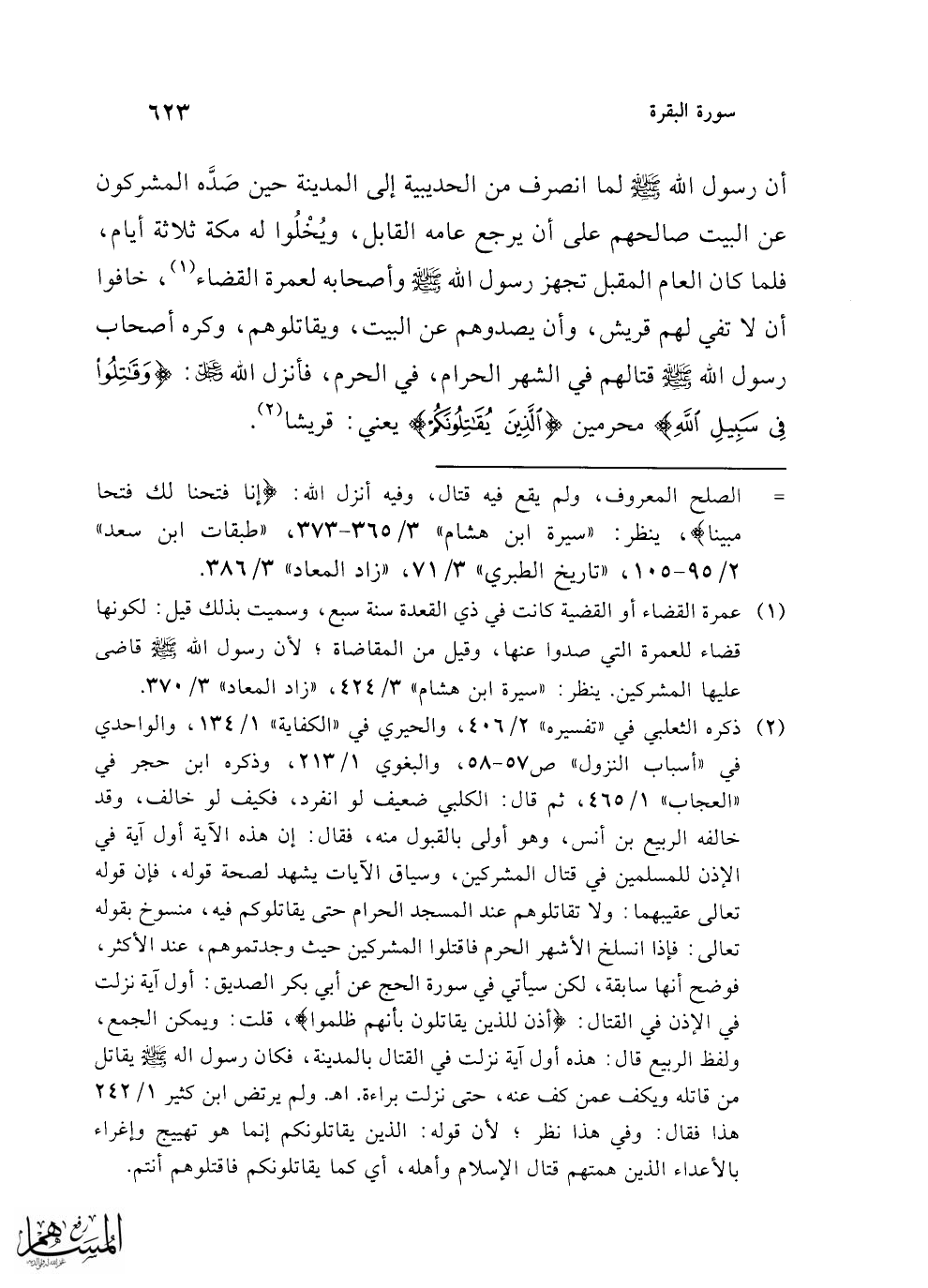
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 3)
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انصرف من الحديبية إلى المدينة حين صَدَّه المشركون عن البيت صالحهم على أن يرجع عامه القابل، ويُخْلُوا له مكة ثلاثة أيام، فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعمرة القضاء (¬1)، خافوا أن لا تفي لهم قريش، وأن يصدوهم عن البيت، ويقاتلوهم، وكره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتالهم في الشهر الحرام، في الحرم، فأنزل الله عز وجل: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} محرمين {الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} يعني: قريشا (¬2).¬__________
= الصلح المعروف، ولم يقع فيه قتال، وفيه أنزل الله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}، ينظر: "سيرة ابن هشام" 3/ 365 - 373، "طبقات ابن سعد" 2/ 95 - 105، "تاريخ الطبري" 3/ 71، "زاد المعاد" 3/ 386.
(¬1) عمرة القضاء أو القضية كانت في ذي القعدة سنة سبع، وسميت بذلك قيل: لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها، وقيل من المقاضاة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى عليها المشركين. ينظر: "سيرة ابن هشام" 3/ 424،"زاد المعاد" 3/ 370.
(¬2) ذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 406، والحيري في "الكفاية" 1/ 134، والواحدي في "أسباب النزول" ص 57 - 58، والبغوي 1/ 213، وذكره ابن حجر في "العجاب" 1/ 465، ثم قال: الكلبي ضعيف لو انفرد، فكيف لو خالف، وقد خالفه الربيع بن أنس، وهو أولى بالقبول منه، فقال: إن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين، وسياق الآيات يشهد لصحة قوله، فإن قوله تعالى عقيبهما: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عند الأكثر، فوضح أنها سابقة، لكن سيأتي في سورة الحج عن أبي بكر الصديق: أول آية نزلت في الإذن في القتال: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}، قلت: ويمكن الجمع، ولفظ الربيع قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت براءة. اهـ. ولم يرتض ابن كثير 1/ 242 هذا فقال: وفي هذا نظر؛ لأن قوله: الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم.