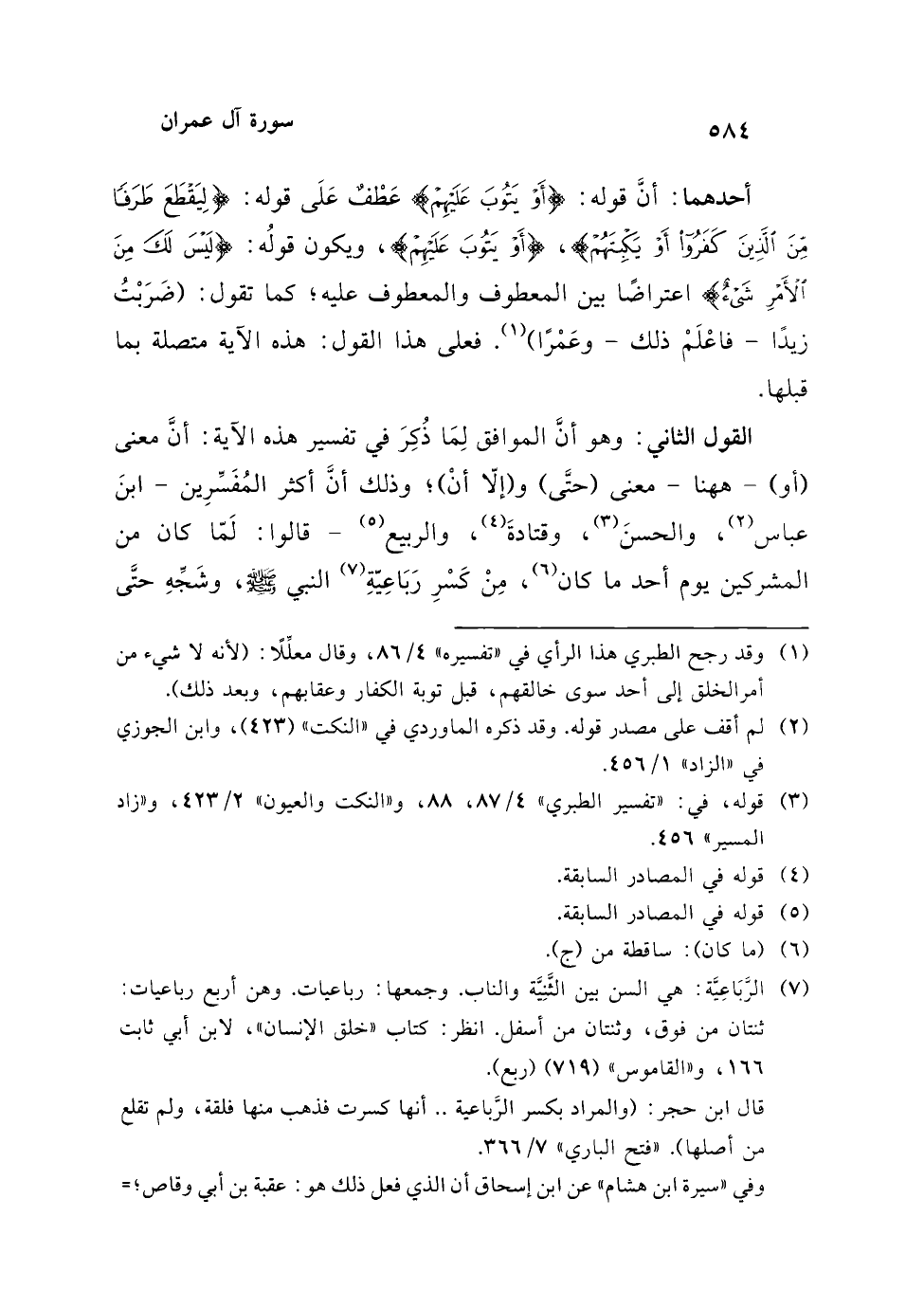
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 5)
أحدهما: أنَّ قوله: {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} عَطْفٌ عَلَى قوله: {لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ}، {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}، ويكون قولُه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ كما تقول: (ضَرَبْتُ زيدًا -فاعْلَمْ ذلك- وعَمْرًا) (¬1). فعلى هذا القول: هذه الآية متصلة بما قبلها.القول الثاني: وهو أنَّ الموافق لِمَا ذُكِرَ في تفسير هذه الآية: أنَّ معنى (أو) -ههنا- معنى (حتَّى) و (إلّا أنْ)؛ وذلك أنَّ أكثر المُفَسِّرِين -ابنَ عباس (¬2)، والحسنَ (¬3)، وقتادةَ (¬4)، والربيع (¬5) - قالوا: لَمّا كان من المشركين يوم أحد ما كان (¬6)، مِنْ كَسْرِ رَبَاعِيّةِ (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشَجِّهِ حتَّى
¬__________
(¬1) وقد رجح الطبري هذا الرأي في "تفسيره" 4/ 86، وقال معلَّلًا: (لأنه لا شيء من أمرالخلق إلى أحد سوى خالقهم، قبل توبة الكفار وعقابهم، وبعد ذلك).
(¬2) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره الماوردي في "النكت" (423)، وابن الجوزي في "الزاد" 1/ 456.
(¬3) قوله، في: "تفسير الطبري" 4/ 87، 88، و"النكت والعيون" 2/ 423، و"زاد المسير" 456.
(¬4) قوله في المصادر السابقة.
(¬5) قوله في المصادر السابقة.
(¬6) (ما كان): ساقطة من (ج).
(¬7) الرَّبَاعِيَّة: هي السن بين الثَّنِيَّة والناب. وجمعها: رباعيات. وهن أربع رباعيات: ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل. انظر: كتاب "خلق الإنسان"، لابن أبي ثابت 166، و"القاموس" (719) (ربع).
قال ابن حجر: (والمراد بكسر الرَّباعية .. أنها كسرت فذهب منها فلقة، ولم تقلع من أصلها). "فتح الباري" 7/ 366.
وفي "سيرة ابن هشام" عن ابن إسحاق أن الذي فعل ذلك هو: عقبة بن أبي وقاص. =