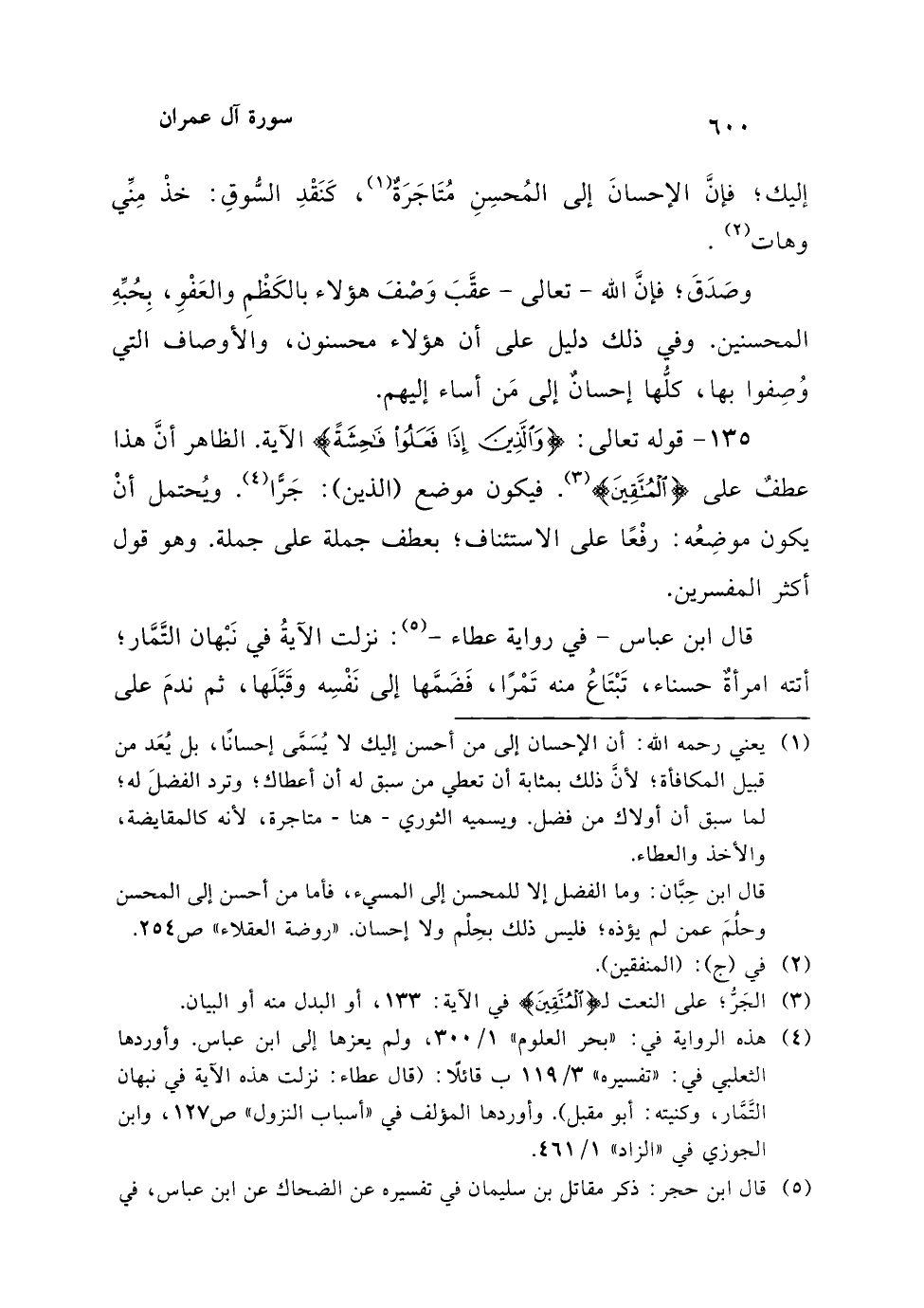
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 5)
إليك؛ فإنَّ الإحسانَ إلى المُحسِنِ مُتَاجَرَةٌ (¬1)، كَنَقْدِ السُّوقِ: خذْ مِنِّي وهات (¬2).وصدَقَ؛ فإنَّ الله -تعالى- عقَّبَ وَصْفَ هؤلاء بالكَظْمِ والعَفْوِ، بِحُبِّهِ المحسنين. وفي ذلك دليل على أن هؤلاء محسنون، والأوصاف التى وُصِفوا بها، كلُّها إحسانٌ إلى مَن أساء إليهم.
135 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} الآية. الظاهر أنَّ هذا عطفٌ على {المُتَّقِينَ} (¬3). فيكون موضع (الذين): جَرًّا (¬4). ويُحتمل أنْ يكون موضِعُه: رفْعًا على الاستئناف؛ بعطف جملة على جملة. وهو قول أكثر المفسرين.
قال ابن عباس -في رواية عطاء- (¬5): نزلت الآيةُ في نَبْهان التَّمَّار؛ أتته امرأة حسناء، تَبْتَاعُ منه تَمْرًا، فَضمَّها إلى نَفْسِه وقَبَّلَها، ثم ندمَ على
¬__________
(¬1) في (أ)، (ب): (متأخره). وفي (ج): (مناحرة). والمثبت من:"تفسير الثعلبي".
(¬2) يعني رحمه الله: أن الإحسان إلى من أحسن إليك لا يُسَمَّى إحسانًا، بل يُعَد من قبيل المكافأة؛ لأنَّ ذلك بمثابة أن تعطي من سبق له أن أعطاك؛ وترد الفضلَ له؛ لما سبق أن أولاك من فضل. ويسميه الثوري -هنا- متاجرة، لأنه كالمقايضة، والأخذ والعطاء.
قال ابن حِبان: وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء، فأما من أحسن إلى المحسن وحلُمَ عمن لم يؤذه؛ فليس ذلك بحِلْم ولا إحسان. "روضة العقلاء" ص 254.
(¬3) في (ج): (المنفقين).
(¬4) الجَرُّ؛ على النعت لـ {المُتَّقِينَ} في الآية: 133، أو البدل منه أو البيان.
(¬5) هذه الرواية في: "بحر العلوم" 1/ 300، ولم يعزها إلى ابن عباس. وأوردها الثعلبي في: "تفسيره" 3/ 119 ب قائلًا: (قال عطاء: نزلت هذه الآية في نبهان التَّمَّار، وكنيته: أبو مقبل). وأوردها المؤلف في "أسباب النزول" ص 127، وابن الجوزي في "الزاد" 1/ 461.