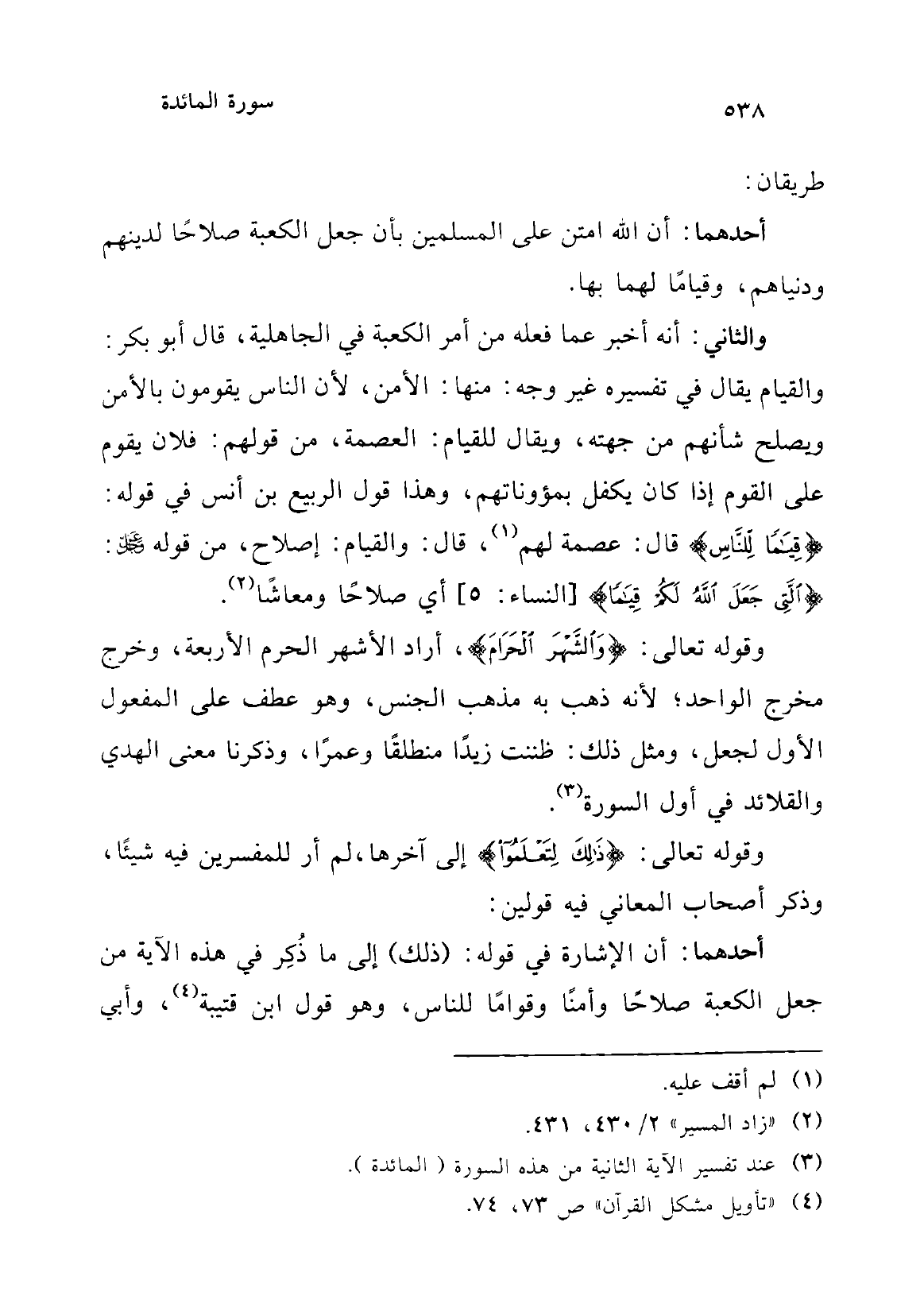
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)
وما في الأرض، وأنه لا يخفى عليه خافية في أرض ولا في سماء (¬1)، فهذه أقوالهم باختلاف ألفاظها مع اتفاق معانيها.والقول الثاني: أن الإشارة في قوله: (ذلك) يعود إلى ما ذكر في هذه السورة من الأنباء والقصص، قال ابن الأنباري: إن الله تعالى خبرَّ في هذه السورة من أخبار الأنبياء وتُبَّاعهم بغيوب كثيرة، وأطع نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على أشياء من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عنهم، مثل قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ} [المائدة: 41] وغير ذلك، فلما دل على غيوب لم تكن تُعلَم قبل نزول السورة قال: (ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي: ذلك الغيب الذي أنبأتكم عن الله تعالى، ويدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض، وأنه لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه عازبة (¬2)، ونحو هذا قال الزجاج، وحكاية قوله يطول، قال: وهذا القول عندي أبين (¬3).
99 - قوله تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}، لما أنذر الله تعالى في قوله: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الآية، بشدة العقاب، وبشر بالعفو والغفران قال: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}، والبلاغ: اسم من التبليغ كالسراح والأداء.
100 - قوله تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ}، قال بعض أهل المعاني: لما ذكر الله تعالى أن على الرسول البلاغ، بين على لسانه أنه لا يستوي عند الله تعالى الحلال والحرام.
وقال المفسرون: نزلت الآية في الحجاج من المشركين الذين أراد
¬__________
(¬1) "زاد المسير" 2/ 431.
(¬2) "معاني الزجاج" 2/ 210، "زاد المسير" 2/ 431.
(¬3) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 210.