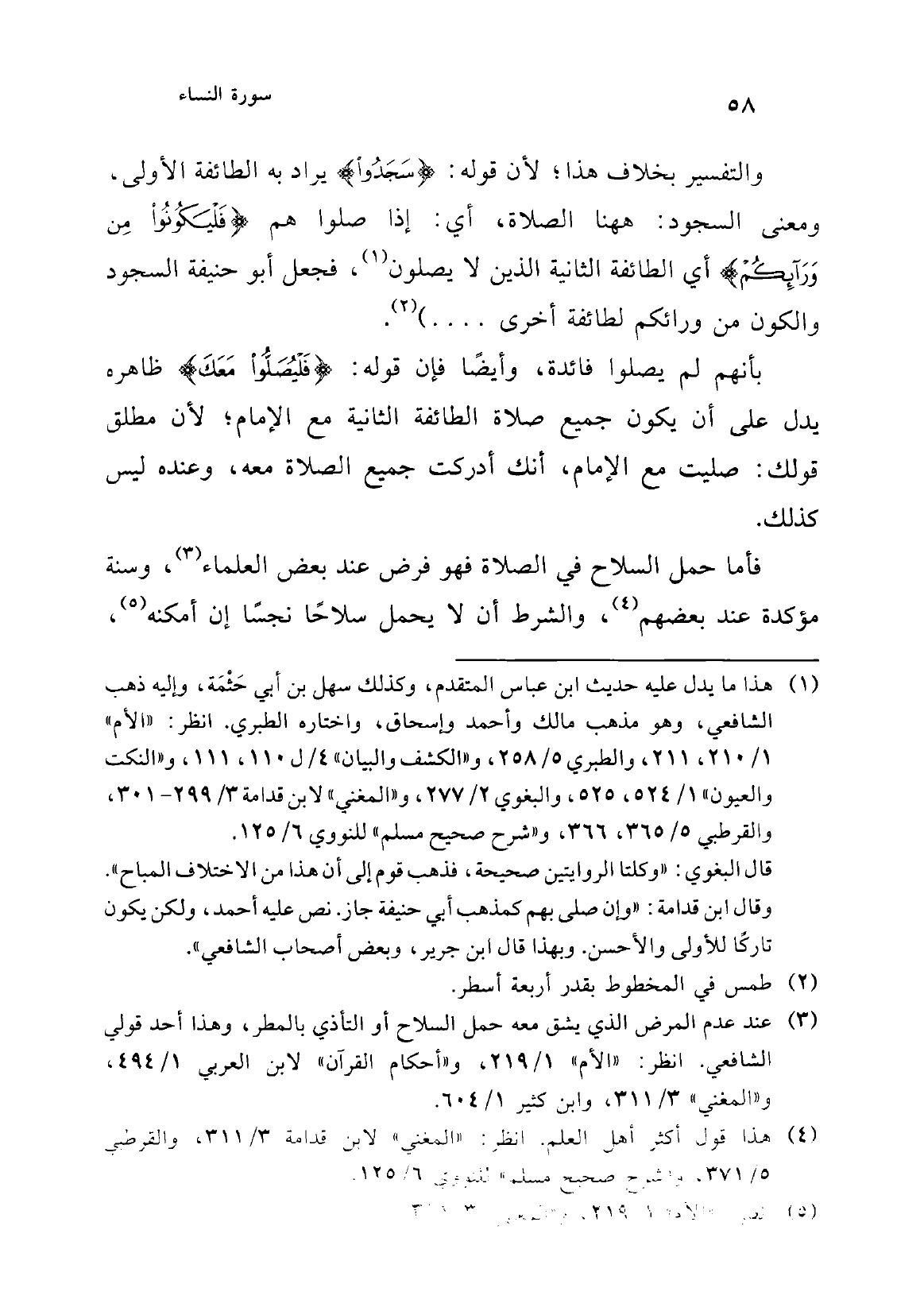
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)
والمسلمون مستدبروها، وفي استقبالهم القبلة يومئذ استدبار منهم لعدوهم، فأمروا بأن يصيروا طائفتين، طائفة تجاه العدو، وطائفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة (¬1).والحال الثانية والثالثة بعُسْفان (¬2) وبذي قَرَد (¬3)، كانوا بخلاف هذه الحال، لأن العدو كان مستدبرًا للقبلة والمسلمون مستقبلوها، وكان المسلمون على (.. (¬4) ..) القبلة والعدو في وجوههم فأتى بالصلاة كما أطلق له من أخذ الحذر (¬5)، ولو أتى بها في هاتين الحالتين كما أمر به يوم ذات الرقاع من تصييرهم طائفتين كان تاركًا للحذر ومغررًا بنفسه وأصحابه. هذا كلامه.
¬__________
(¬1) جاءت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في عدة أحاديث أخرجها البخاري (4129، 4130) في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (842، 843) في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف.
(¬2) قرية بين مكة والمدينة على بعد مرحلتين من مكة. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" الجزء الثالث، القسم الثاني ص 56.
(¬3) بفتح القاف والراء اسم لماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر، وسمي به غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي أغار فيها قوم من غطفان على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستردها، وهي قبل خيبر بثلاث. انظر: "صحيح البخاري" (4194)، و"معجم البلدان" 4/ 322، و"اللسان" 6/ 3577.
(¬4) كلمة غير واضحة، وأظنها: (مستقبل).
(¬5) الأثر في صلاة الخوف بعسفان أخرجه النسائي 3/ 74 في كتاب: صلاة الخوف حديث رقم (16) عن أبي هريرة، والطبري 5/ 257 - 258 عن ابن عباس ومجاهد وهو في "تفسير مجاهد" 1/ 172، وذكره الثعلبي 4/ 112 أوصفتها بنحو ما في حديث جابر الآتي.
أما بذي قرد فقد قال ابن عباس: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني صلاة الخوف بذي قرد". أخرجه البخاري (4125) (سبق تخريجه)، وأخرجه مطولًا عنه النسائي حيث =