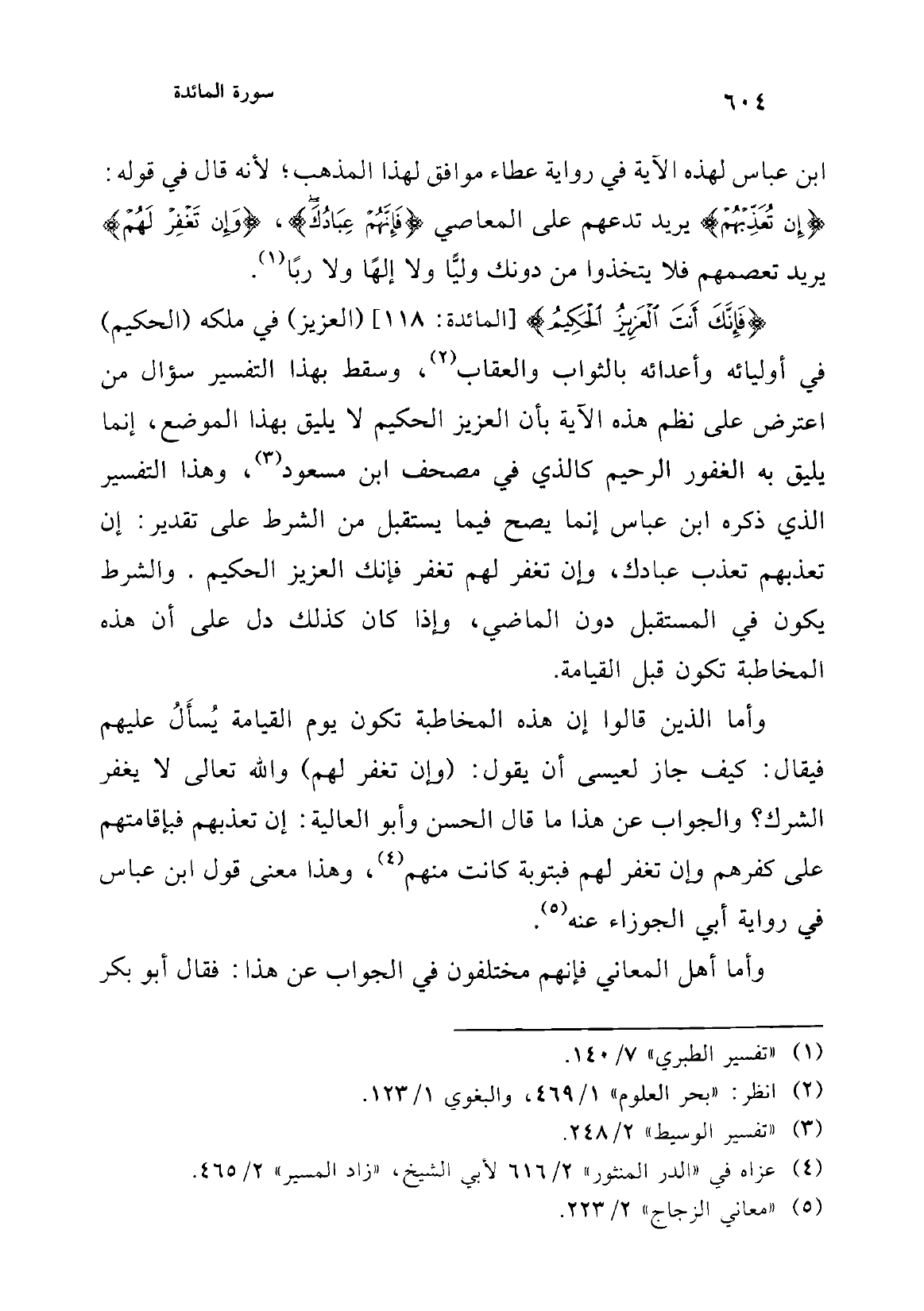
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)
وذهب جماعة من أصحاب المعاني أن هذا على طريق تفويض الأمر إلى الله، إذ هو العالم بباطن أمرهم وظاهره، ومن أخلص التوبة منهم ومن أقام على كفره، ولم يشك عيسى في أنه يعذب الكفار، ولكن رد الأمر إلى مالكهم وإلههم، وتبرأ مما كان منهم؛ ليخرج نفسه من حالات المعترضين المقترحين، أي: إن عذبتهم يا رب لم يكن لي ولا لأحد الاعتراض عليك، وإن غفرت لهم ولست فاعلًا فذلك غير مردود عليك (¬1)، ولهذا المعنى قال: {فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} دون الغفور الرحيم؛ لأنه ليس قوله: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ} على معنى مسألة الغفران لهم، وإنما هو على تسليم الأمر إلى من كان أملك بهم، ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأوهم أنه دعا بالمغفرة، وهذا الذي ذكرنا من أن هذا على معنى التفويض مذهب الكلبي، فقد روى حبان عنه في هذه الآية قال: غبت عنهم وتركتهم على الحق فما أدري ما أحدثوا (¬2).119 - قوله تعالى: {قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} في الدنيا {صِدْقُهُمْ} في الآخرة؛ لأنه يوم الإثابة والجزاء، وما تقدم في الدنيا من الصدق إنما يتبين نفعه في هذا اليوم الذي نيل فيه جزاؤه (¬3).
والدليل على أن المراد بالصادقين الذين صدقوا في الدنيا لا الصادقين في ذلك اليوم، أن الكفار لا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم بما يكون من الإقرار على أنفسهم بالمعصية.
قال المفسرون: هذا تصديق لعيسى بما يقول من قوله: {مَا قُلْتُ لَهُمْ} الآية، وذلك أنه كان صادقًا في الدنيا ولم يقل للنصارى اتخذوني إلهًا،
¬__________
(¬1) "زاد المسير" 2/ 465، ونسب نحو هذا القول لابن الأنباري.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) "تفسير الطبري" 7/ 141.