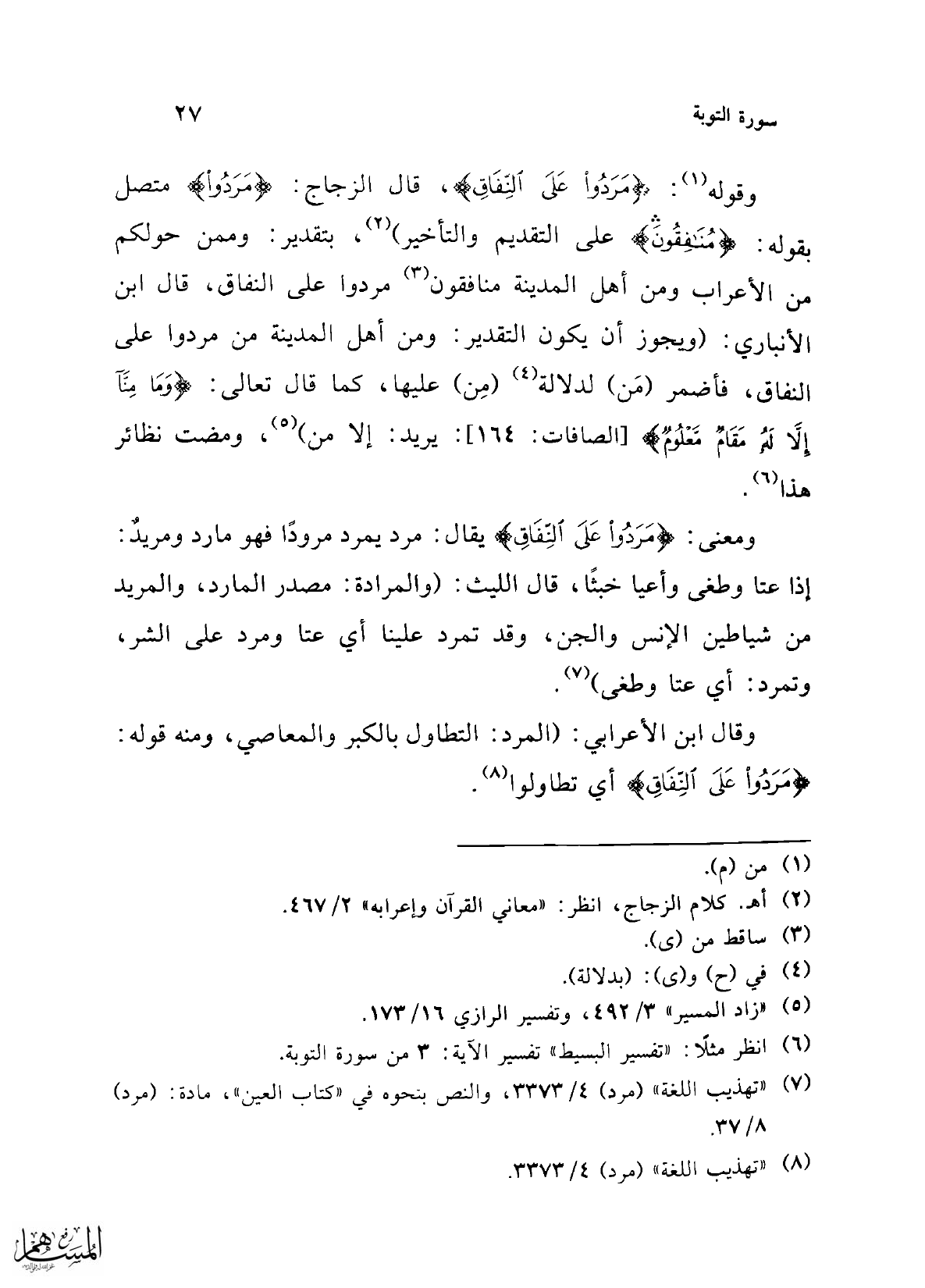
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 11)
وقوله (¬1): {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}، قال الزجاج: {مَرَدُوا} متصل بقوله: {مُنَافِقُونَ} على التقديم والتأخير) (¬2)، بتقدير: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون (¬3) مردوا على النفاق، قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يكون التقدير: ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق، فأضمر (مَن) لدلالة (¬4) (مِن) عليها، كما قال تعالى: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164]: يريد: إلا من) (¬5)، ومضت نظائر هذا (¬6).ومعنى: {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} يقال: مرد يمرد مرودًا فهو مارد ومريدٌ: إذا عتا وطغى وأعيا خبثًا، قال الليث: (والمرادة: مصدر المارد، والمريد من شياطين الإنس والجن، وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشر، وتمرد: أي عتا وطغى) (¬7).
وقال ابن الأعرابي: (المرد: التطاول بالكبر والمعاصي، ومنه قوله: {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} أي تطاولوا (¬8).
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) أهـ. كلام الزجاج، انظر: "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 467.
(¬3) ساقط من (ى).
(¬4) في (ح) و (ى): (بدلالة).
(¬5) "زاد المسير" 3/ 492، وتفسير الرازي 16/ 173.
(¬6) انظر مثلًا: "تفسير البسيط" تفسير الآية: 3 من سورة التوبة
(¬7) "تهذيب اللغة" (مرد) 4/ 3373، والنص بنحوه في "كتاب العين"، مادة: (مرد) 8/ 37.
(¬8) "تهذيب اللغة" (مرد) 4/ 3373.