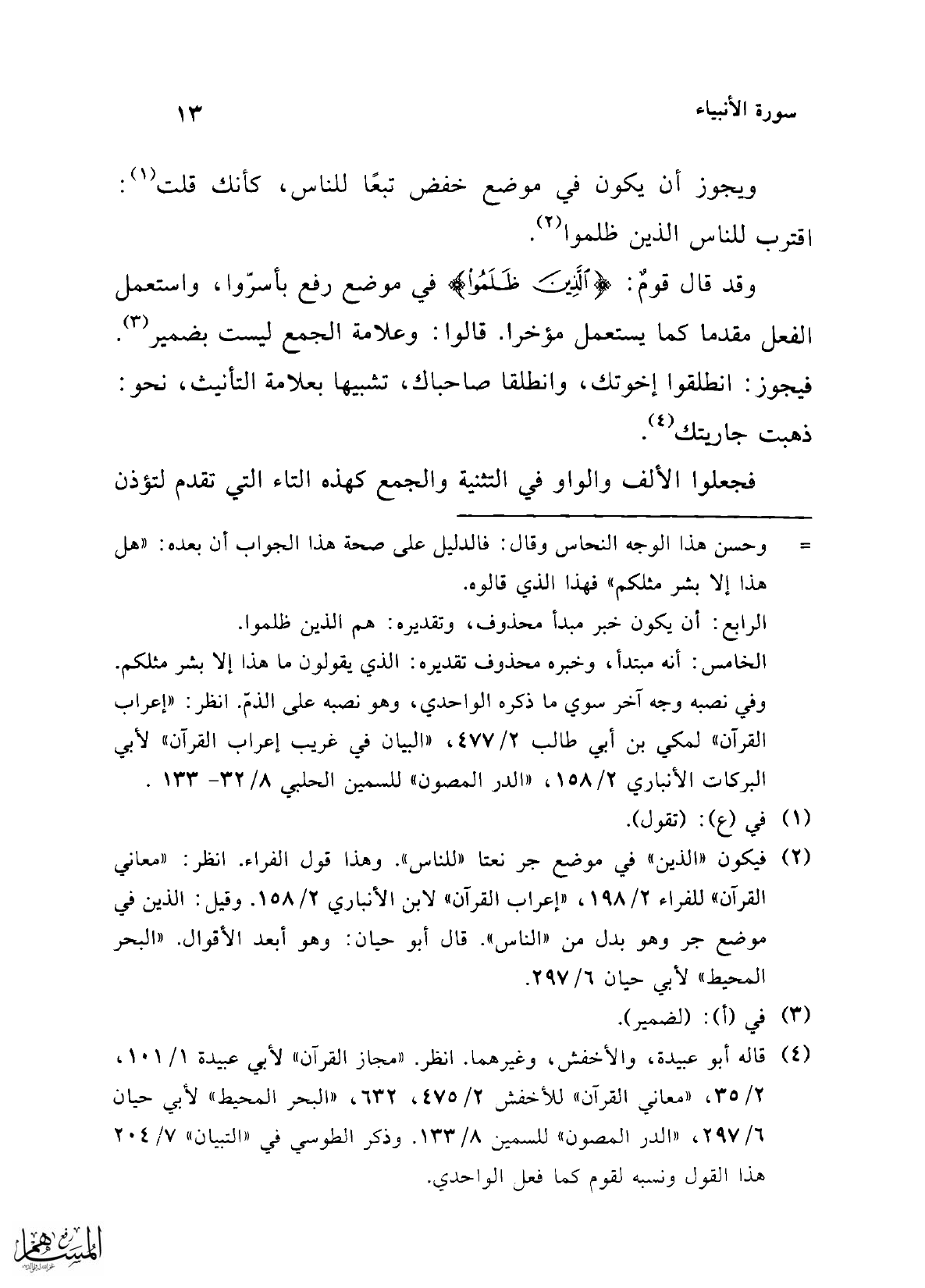
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 15)
ويجوز أن يكون في موضع خفض تبعًا للناس، كأنك قلت (¬1): اقترب للناس الذين ظلموا (¬2).وقد قال قومٌ: {الَّذِينَ ظَلَمُوا} في موضع رفع بأسرّوا، واستعمل الفعل مقدما كما يستعمل مؤخرا. قالوا: وعلامة الجمع ليست بضمير (¬3). فيجوز: انطلقوا إخوتك، وانطلقا صاحباك، تشبيها بعلامة التأنيث، نحو: ذهبت جاريتك (¬4).
فجعلوا الألف والواو في التثنية والجمع كهذه التاء التي تقدم لتؤذن
¬__________
= وحسن هذا الوجه النحاس وقال: فالدليل على صحة هذا الجواب أن بعده: "هل هذا إلا بشر مثلكم" فهذا الذي قالوه.
الرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: هم الذين ظلموا.
الخامس: أنه مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: الذي يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. وفي نصبه وجه آخر سوي ما ذكره الواحدي، وهو نصبه على الذمّ. انظر: "إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب 2/ 477، "البيان في غريب إعراب القرآن" لأبي البركات الأنباري 2/ 158، "الدر المصون" للسمين الحلبي 8/ 32 - 133.
(¬1) في (ع): (تقول).
(¬2) فيكون "الذين" في موضع جر نعتا "للناس". وهذا قول الفراء. انظر: "معاني القرآن" للفراء 2/ 198، "إعراب القرآن" لابن الأنباري 2/ 158. وقيل: الذين في موضع جر وهو بدل من "الناس". قال أبو حيان: وهو أبعد الأقوال. "البحر المحيط" لأبي حيان 6/ 297.
(¬3) في (أ): (لضمير).
(¬4) قاله أبو عبيدة، والأخفش، وغيرهما. انظر. "مجاز القرآن" لأبي عبيدة 1/ 101، 2/ 35، "معاني القرآن" للأخفش 2/ 475، 632، "البحر المحيط" لأبي حيان 6/ 297، "الدر المصون" للسمين 8/ 133. وذكر الطوسي "التبيان" 7/ 204 هذا القول ونسبه لقوم كما فعل الواحدي.