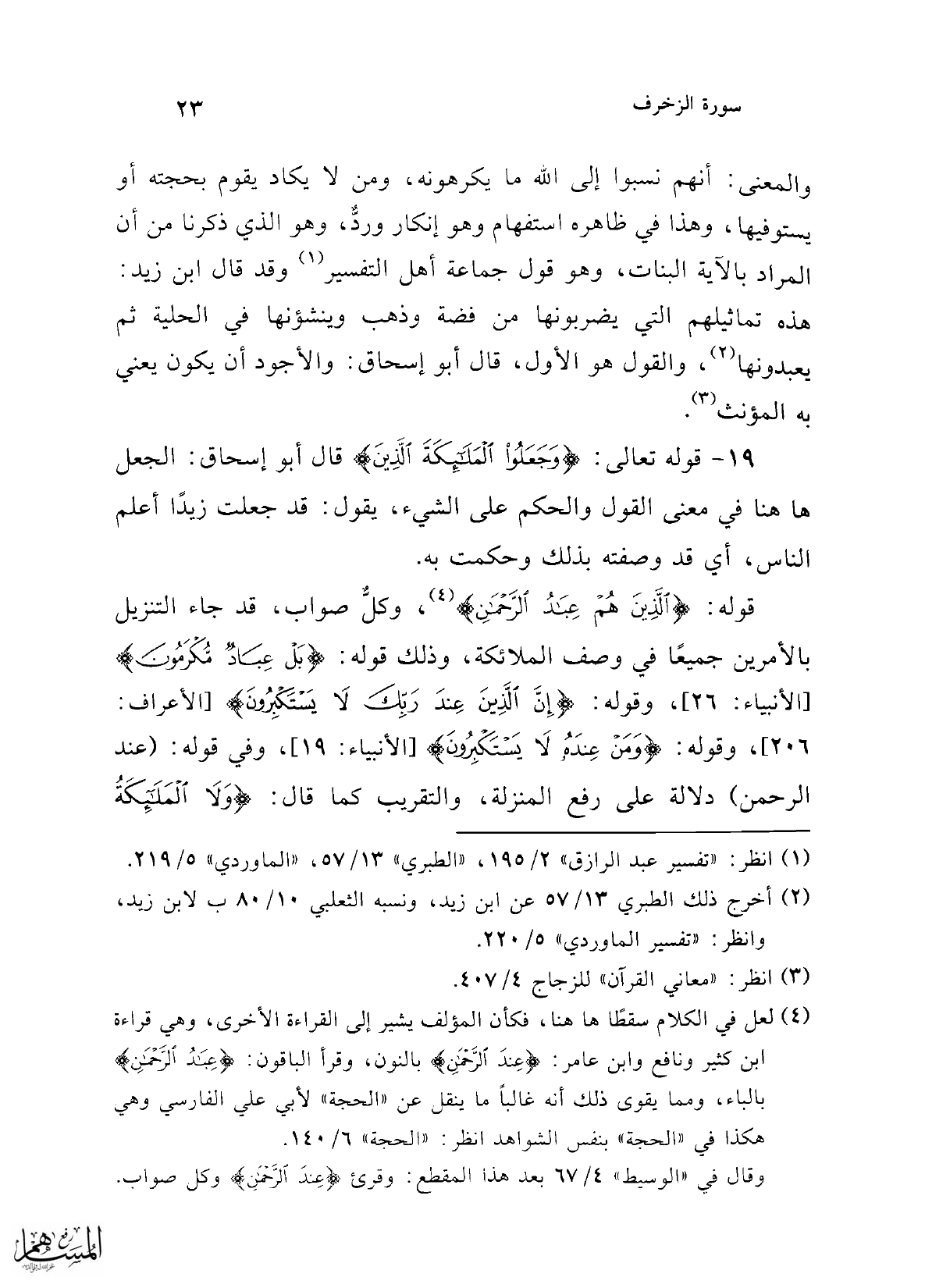
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 20)
والمعنى: أنهم نسبوا إلى الله ما يكرهونه، ومن لا يكاد يقوم بحجته أو يستوفيها، وهذا في ظاهره استفهام وهو إنكار وردٌّ، وهو الذي ذكرنا من أن المراد بالآية البنات، وهو قول جماعة أهل التفسير (¬1) وقد قال ابن زيد: هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب وينشؤنها في الحلية ثم يعبدونها (¬2)، والقول هو الأول، قال أبو إسحاق: والأجود أن يكون يعني به المؤنث (¬3).19 - قوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ} قال أبو إسحاق: الجعل هاهنا في معنى القول والحكم على الشيء، يقول: قد جعلت زيدًا أعلم الناس، أي قد وصفته بذلك وحكمت به.
قوله: {الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ} (¬4)، وكلٌّ صواب، قد جاء التنزيل بالأمرين جميعًا في وصف الملائكة، وذلك قوله: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [الأعراف: 206]، وقوله: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [الأنبياء: 19]، وفي قوله: (عند الرحمن) دلالة على رفع المنزلة، والتقريب كما قال: {وَلَا الْمَلَائِكَةُ
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير عبد الرازق" 2/ 195، "الطبري" 13/ 57، "الماوردي" 5/ 219.
(¬2) أخرج ذلك الطبري 13/ 57 عن ابن زيد، ونسبه الثعلبي 10/ 80 ب لابن زيد، وانظر: "تفسير الماوردي" 5/ 220.
(¬3) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 4/ 407.
(¬4) لعل في الكلام سقطًا هاهنا، فكأن المؤلف يشير إلى القراءة الأخرى، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر: {عِندَ الرَّحْمَنِ} بالنون، وقرأ الباقون: {عِبَادُ الرَّحْمَنِ} بالباء، ومما يقوى ذلك أنه غالباً ما ينقل عن "الحجة" لأبي علي الفارسي وهي هكذا في "الحجة" بنفس الشواهد انظر: "الحجة" 6/ 140.
وقال في "الوسيط" 4/ 67 بعد هذا المقطع: وقرئ {عِندَ الرَّحْمَنِ} وكل صواب.