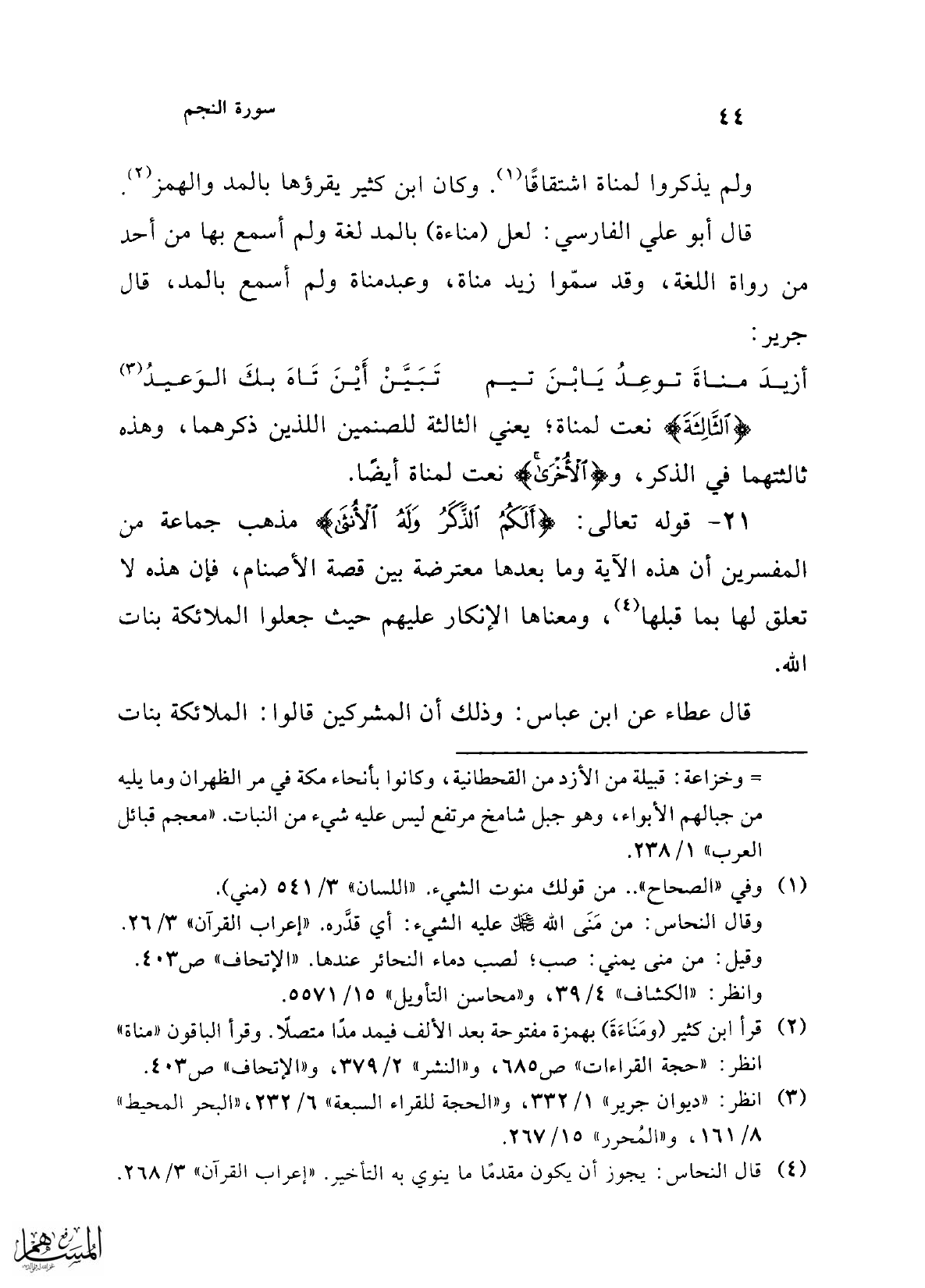
كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 21)
ولم يذكروا لمناة اشتقاقًا (¬1). وكان ابن كثير يقرؤها بالمد والهمز (¬2).قال أبو علي الفارسي: لعل (مناءة) بالمد لغة ولم أسمع بها من أحد من رواة اللغة، وقد سمّوا زيد مناة، وعبد مناة ولم أسمع بالمد، قال جرير:
أزيدَ مناةَ توعِدُ يَابْنَ تيم ... تَبَيَّنْ أَيْنَ تَاهَ بكَ الوَعيدُ (¬3)
{الثَّالِثَةَ} نعت لمناة؛ يعني الثالثة للصنمين اللذين ذكرهما، وهذه ثالثتهما في الذكر، و {الْأُخْرَى} نعت لمناة أيضًا.
21 - قوله تعالى: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى} مذهب جماعة من المفسرين أن هذه الآية وما بعدها معترضة بين قصة الأصنام، فإن هذه لا تعلق لها بما قبلها (¬4)، ومعناها الإنكار عليهم حيث جعلوا الملائكة بنات الله.
قال عطاء عن ابن عباس: وذلك أن المشركين قالوا: الملائكة بنات
¬__________
= وخزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، وكانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه من جبالهم الأبواء، وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. "معجم قبائل العرب" 1/ 238.
(¬1) وفي "الصحاح" .. من قولك منوت الشيء. "اللسان" 3/ 541 (مني).
وقال النحاس: من مَنَى الله -عز وجل- عليه الشيء: أي قدَّره. "إعراب القرآن" 3/ 26. وقيل: من مني يمني: صب؛ لصب دماء النحائر عندها. "الإتحاف" ص 403. وانظر: "الكشاف" 4/ 39، و"محاسن التأويل" 15/ 5571.
(¬2) قرأ ابن كثير (ومَنَاءَةَ) بهمزة مفتوحة بعد الألف فيمد مدًا متصلاً. وقرأ الباقون "مناة" انظر: "حجة القراءات" ص 685، و"النشر" 2/ 379، و"الإتحاف" ص 403.
(¬3) انظر: "ديوان جرير" 1/ 332، و"الحجة للقراء السبعة" 6/ 232، "البحر المحيط" 8/ 161، و"المُحرر" 15/ 267.
(¬4) قال النحاس: يجوز أن يكون مقدمًا ما ينوي به التآخير. "إعراب القرآن" 3/ 268.