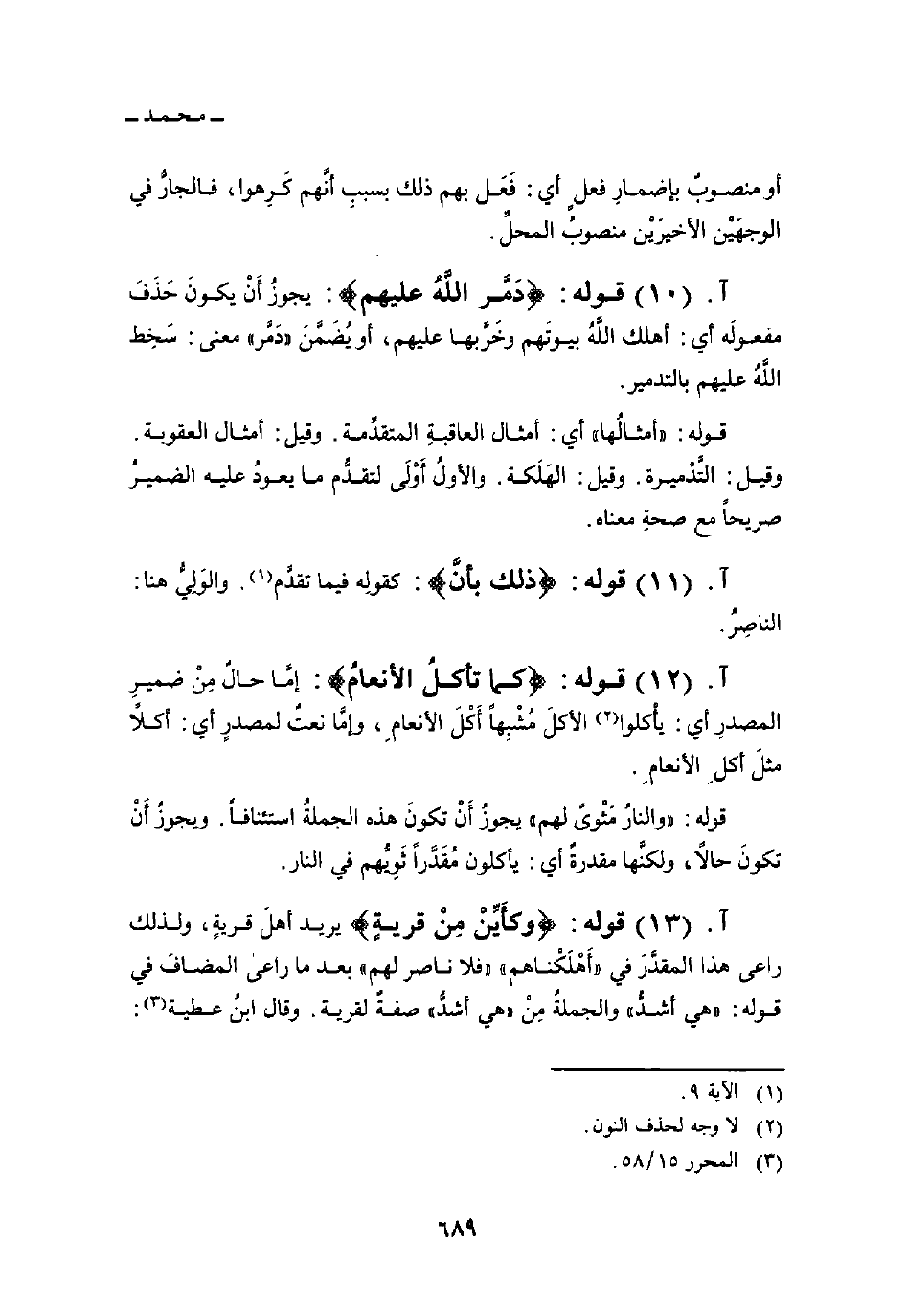
كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (اسم الجزء: 9)
أو منصوبٌ بإضمارِ فعلٍ أي: فَعَل بهم ذلك بسببِ أنَّهم كَرِهوا، فالجارُّ في الوجهَيْن الأخيرَيْن منصوبُ المحلِّ.قوله: {دَمَّرَ الله عَلَيْهِمْ} : يجوزُ أَنْ يكونَ حَذَفَ مفعولَه أي: أهلك اللَّهُ بيوتَهم وخَرَّبها عليهم، أو يُضَمَّنَ «دَمَّر» معنى: سَخِط اللَّهُ عليهم بالتدمير.
قوله: «أمثالُها» أي: أمثال العاقبةِ المتقدِّمة. وقيل: أمثال العقوبة. وقيل: التَّدْميرة. وقيل: الهَلَكة. والأولُ أَوْلَى لتقدُّم ما يعودُ عليه الضميرُ صريحاً مع صحةِ معناه.
قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ} : كقولِه فيما تقدَّم. والوَلِيُّ هنا: الناصِرُ.
قوله: {كَمَا تَأْكُلُ الأنعام} : إمَّا حالٌ مِنْ ضميرِ المصدرِ أي: يأْكلوا الأكلَ مُشْبِهاً أَكْلَ الأنعام، وإمَّا نعتٌ لمصدرٍ أي: أكلاً مثلَ أكلِ الأنعامِ.
قوله: {والنار مَثْوًى لَّهُمْ} يجوزُ أَنْ تكونَ هذه الجملةُ استئنافاً. ويجوزُ أَنْ تكونَ حالاً، ولكنَّها مقدرةٌ أي: يأكلون مُقَدَّراً ثَوِيُّهم في النار.
قوله: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ} يريد أهلَ قريةٍ، ولذلك راعى هذا المقدَّرَ في «أَهْلَكْناهم» {فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ} بعد ما راعى المضافَ في قوله: «هي أشدُّ» والجملةُ مِنْ «هي أشدُّ» صفةٌ لقرية. وقال ابنُ عطية: «