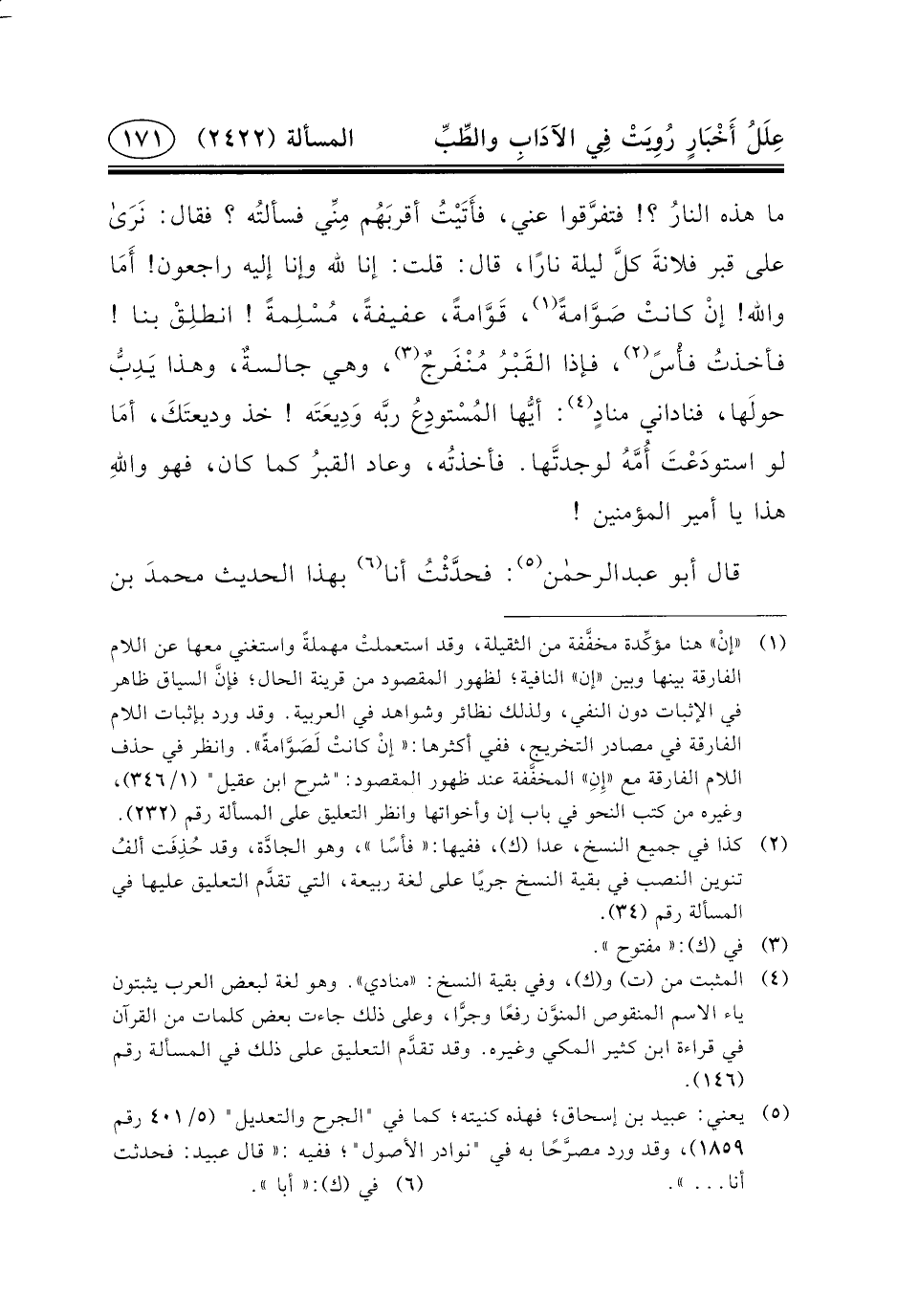
كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 6)
مَا هَذِهِ النارُ؟! فتفرَّقوا عَنِّي، فأَتَيْتُ أقربَهُم مِنِّي فسألتُه؟ فَقَالَ: نَرَى عَلَى قَبْرِ فلانةَ كلَّ لَيْلَةٍ نَارًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أَمَا وَاللَّهِ! إنْ كانتْ صَوَّامةً (١) ،قَوَّامةً، عَفِيفَةً، مُسْلِمةً! انطلِقْ بِنَا! فأخذتُ فأْسً (٢) ، فَإِذَا القَبْرُ مُنْفَرجٌ (٣) ، وَهِيَ جالسةٌ، وَهَذَا يَدِبُّ حولَها، فَنَادَانِي منادٍ (٤) : أيُّها المُسْتودِعُ ربَّه وَدِيعَتَه! خُذْ وديعتَكَ، أمَا لَوِ استودَعْتَ أُمَّهُ لوجدتَّها. فأخذتُه، وَعَادَ القبرُ كَمَا كَانَ، فَهُوَ واللهِ هَذَا يَا أمير المؤمنين!
قال أبو عبد الرحمن (٥) : فحدَّثْتُ أنا (٦) بهذا الْحَدِيث محمدَ بن
---------------
(١) «إنْ» هنا مؤكِّدة مخفَّفة من الثقيلة، وقد استعملتْ مهملةً واستغني معها عن اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية؛ لظهور المقصود من قرينة الحال؛ فإنَّ السياق ظاهر في الإثبات دون النفي، ولذلك نظائر وشواهد في العربية. وقد ورد بإثبات اللام الفارقة في مصادر التخريج، ففي أكثرها: «إنْ كانتْ لَصَوَّامةً» . وانظر في حذف اللام = = الفارقة مع «إِنِ» المخفَّفة عند ظهور المقصود: "شرح ابن عقيل" (١/٣٤٦) ، وغيره من كتب النحو في باب إن وأخواتها وانظر التعليق على المسألة رقم (٢٣٢) ..
(٢) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ، ففيها: «فأسًا» ، وهو الجادَّة، وقد حُذِفَت ألفُ تنوين النصب في بقية النسخ جريًا على لغة ربيعة، التي تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٣) في (ك) : «مفتوح» .
(٤) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «منادي» . وهو لغة لبعض العرب يثبتون ياء الاسم المنقوص المنوَّن رفعًا وجرًّا، وعلى ذلك جاءت بعض كلمات من القرآن في قراءة ابن كثير المكي وغيره. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٤٦) .
(٥) يعني: عبيد بن إسحاق؛ فهذه كنيته؛ كما في "الجرح والتعديل" (٥/٤٠١ رقم ١٨٥٩) ، وقد ورد مصرَّحًا به في "نوادر الأصول"؛ ففيه: «قال عبيد: فحدثت أنا ... » .
(٦) في (ك) : «أبا» .