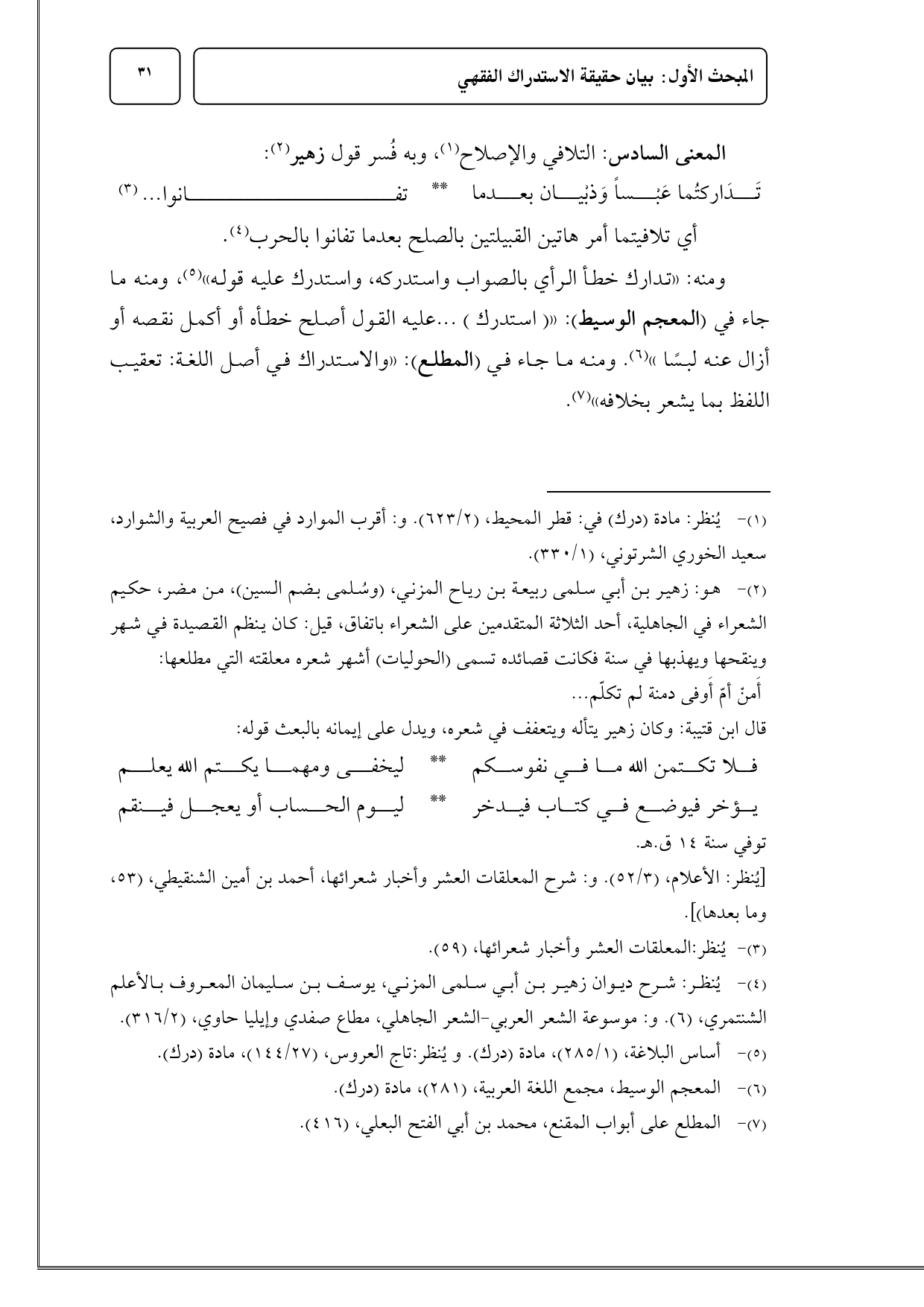
كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا
المعنى السادس: التلافي والإصلاح (¬1)، وبه فُسر قول زهير (¬2):تَدَاركتُما عَبْساً وَذبْيان بعدما ... تفانوا ... (¬3)
أي تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بالصلح بعدما تفانوا بالحرب (¬4).
ومنه: «تدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه، واستدرك عليه قوله» (¬5)، ومنه ما جاء في (المعجم الوسيط): «(استدرك) ... عليه القول أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسًا» (¬6). ومنه ما جاء في (المطلع): «والاستدراك في أصل اللغة: تعقيب اللفظ بما يشعر بخلافه» (¬7).
¬_________
(¬1) يُنظر: مادة (درك) في: قطر المحيط، (2/ 623). و: أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، سعيد الخوري الشرتوني، (1/ 330).
(¬2) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، (وسُلمى بضم السين)، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، أحد الثلاثة المتقدمين على الشعراء باتفاق، قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى (الحوليات) أشهر شعره معلقته التي مطلعها:
أَمنْ أمّ أَوفى دمنة لم تكلّم ...
قال ابن قتيبة: وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره، ويدل على إيمانه بالبعث قوله:
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ... ليخفى ومهما يكتم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ... ليوم الحساب أو يعجل فينقم
توفي سنة 14 ق. هـ.
[يُنظر: الأعلام، (3/ 52). و: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، أحمد بن أمين الشنقيطي، (53، وما بعدها)].
(¬3) يُنظر: المعلقات العشر وأخبار شعرائها، (59).
(¬4) يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري، (6). و: موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي، مطاع صفدي وإيليا حاوي، (2/ 316).
(¬5) أساس البلاغة، (1/ 285)، مادة (درك). ويُنظر: تاج العروس، (27/ 144)، مادة (درك).
(¬6) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (281)، مادة (درك).
(¬7) المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي، (416).