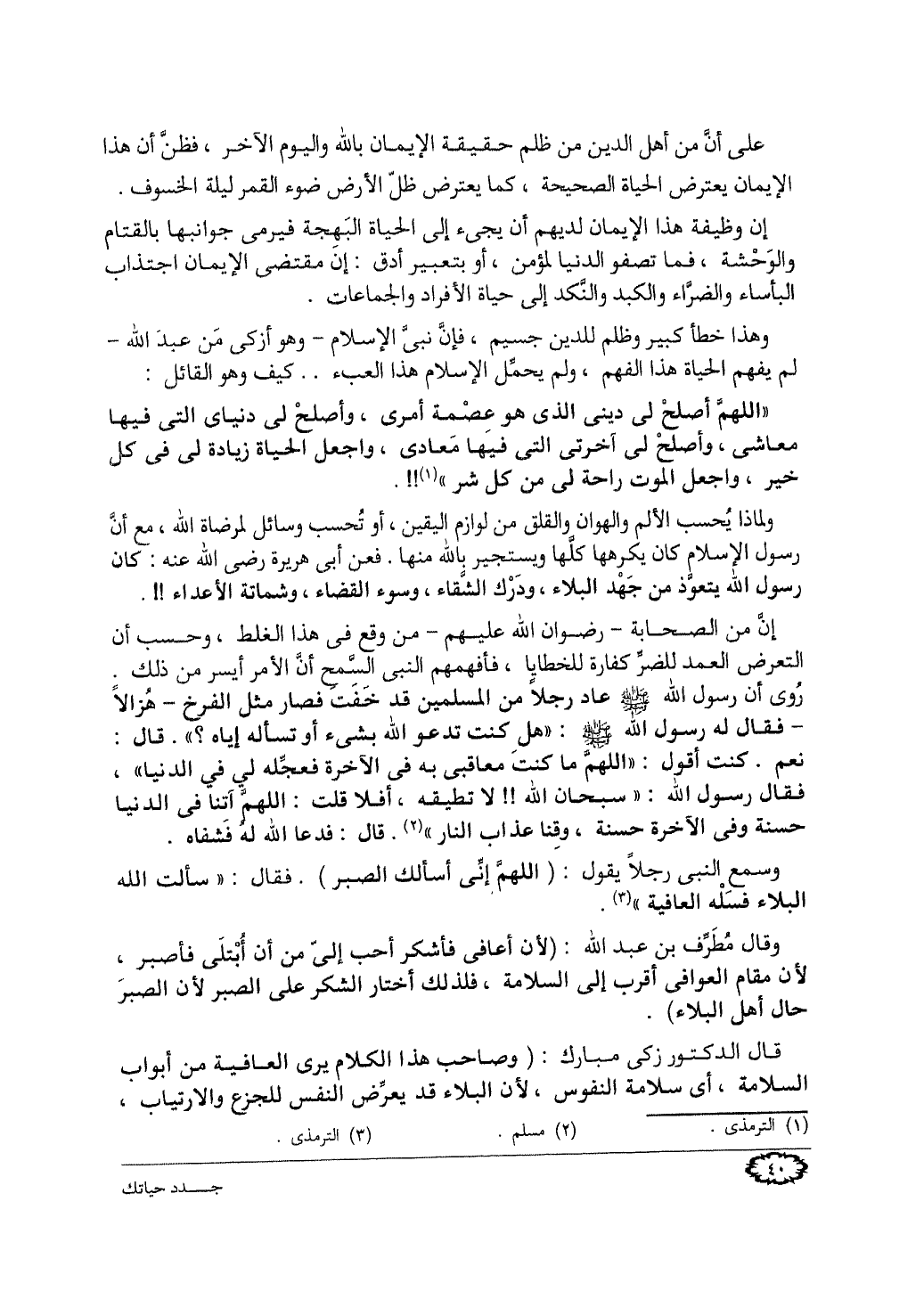
كتاب جدد حياتك
على أن من أهل الدين من ظلم حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، فظن أن هذا الإيمان يعترض الحياة الصحيحة، كما يعترض ظل الأرض ضوء القمر ليلة الخسوف.إن وظيفة هذا الإيمان لديهم أن يجىء إلى الحياة البهجة فيرمى جوانبها بالقتام والوحشة، فما تصفو الدنيا لمؤمن، أو بتعبير أدق: إن مقتضى الإيمان اجتذاب البأساء والضراء والكبد والنكد إلى حياة الأفراد والجماعات.
وهذا خطأ كبير وظلم للدين جسيم، فإن نبى الإسلام- وهو أزكى مَنْ عَبَدَ الله- لم يفهم الحياة هذا الفهم، ولم يحمِّل الإسلام هذا العبء .. كيف وهو القائل: "اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير، واجعل الموت راحة لى من كل شر "!!.
ولماذا يحسب الألم والهوان والقلق من لوازم اليقين، أو تحسب وسائل لمرضاة الله، مع أن رسول الإسلام كان يكرهها كلها ويستجير بالله منها. فعن أبى هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء!!.
إن من الصحابة- رضوان الله عليهم- من وقع فى هذا الغلط، وحسب أن التعرض العمد للضر كفارة للخطايا، فأفهمهم النبى السمح أن الأمر أيسر من ذلك روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ- هزالا - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟ ". قال: نعم. كنت أقول: "اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لي فى الدنيا"، فقال رسول الله: " سبحان الله!! لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ". قال: فدعا الله له فشفاه.
وسمع النبى رجلا يقول: (اللهم إنى أسألك الصبر). فقال: " سألت الله البلاء فسله العافية ".
وقال مُطرِّف بن عبد الله: (لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر، لأن مقام العوافى أقرب إلى السلامة، فلذلك أختار الشكر على الصبر لأن الصبر حال أهل البلاء).
قال الدكتور زكى مبارك: (وصاحب هذا الكلام يرى العافية من أبواب السلامة، أى سلامة النفوس، لأن البلاء قد يعرض النفس للجزع والارتياب،