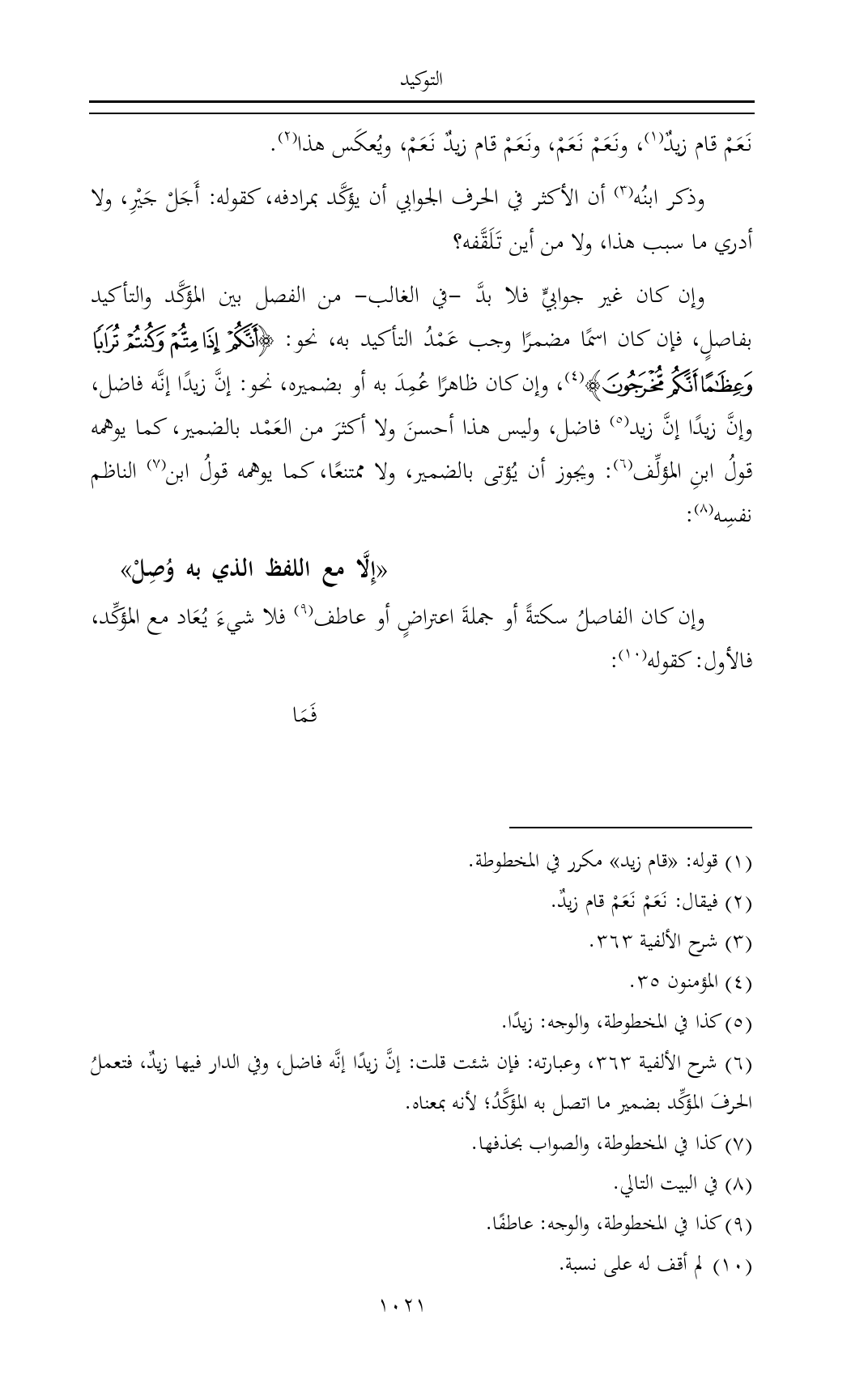
كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
نَعَمْ، ويُعكَس هذا (¬١).وذكر ابنُه (¬٢) أن الأكثر في الحرف الجوابي أن يؤكَّد بمرادفه، كقوله: أَجَلْ جَيْرِ، ولا أدري ما سبب هذا، ولا من أين تَلَقَّفه؟
وإن كان غير جوابيٍّ فلا بدَّ -في الغالب- من الفصل بين المؤكَّد والتأكيد بفاصلٍ، فإن كان اسمًا مضمرًا وجب عَمْدُ التأكيد به، نحو: {أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} (¬٣)، وإن كان ظاهرًا عُمِدَ به أو بضميره، نحو: إنَّ زيدًا إنَّه فاضل، وإنَّ زيدًا إنَّ زيد (¬٤) فاضل، وليس هذا أحسنَ ولا أكثرَ من العَمْد بالضمير، كما يوهمه قولُ ابنِ المؤلِّف (¬٥): ويجوز أن يُؤتى بالضمير، ولا ممتنعًا، كما يوهمه قولُ ابن (¬٦) الناظم نفسِه (¬٧):
«إِلَّا مع اللفظ الذي به وُصِلْ»
وإن كان الفاصلُ سكتةً أو جملةَ اعتراضٍ أو عاطف (¬٨) فلا شيءَ يُعَاد مع المؤكِّد، فالأول: كقوله (¬٩):
... ... فَمَا
---------------
(¬١) فيقال: نَعَمْ نَعَمْ قام زيدٌ.
(¬٢) شرح الألفية ٣٦٣.
(¬٣) المؤمنون ٣٥.
(¬٤) كذا في المخطوطة، والوجه: زيدًا.
(¬٥) شرح الألفية ٣٦٣، وعبارته: فإن شئت قلت: إنَّ زيدًا إنَّه فاضل، وفي الدار فيها زيدٌ، فتعملُ الحرفَ المؤكِّد بضمير ما اتصل به المؤكَّدُ؛ لأنه بمعناه.
(¬٦) كذا في المخطوطة، والصواب بحذفها.
(¬٧) في البيت التالي.
(¬٨) كذا في المخطوطة، والوجه: عاطفًا.
(¬٩) لم أقف له على نسبة.