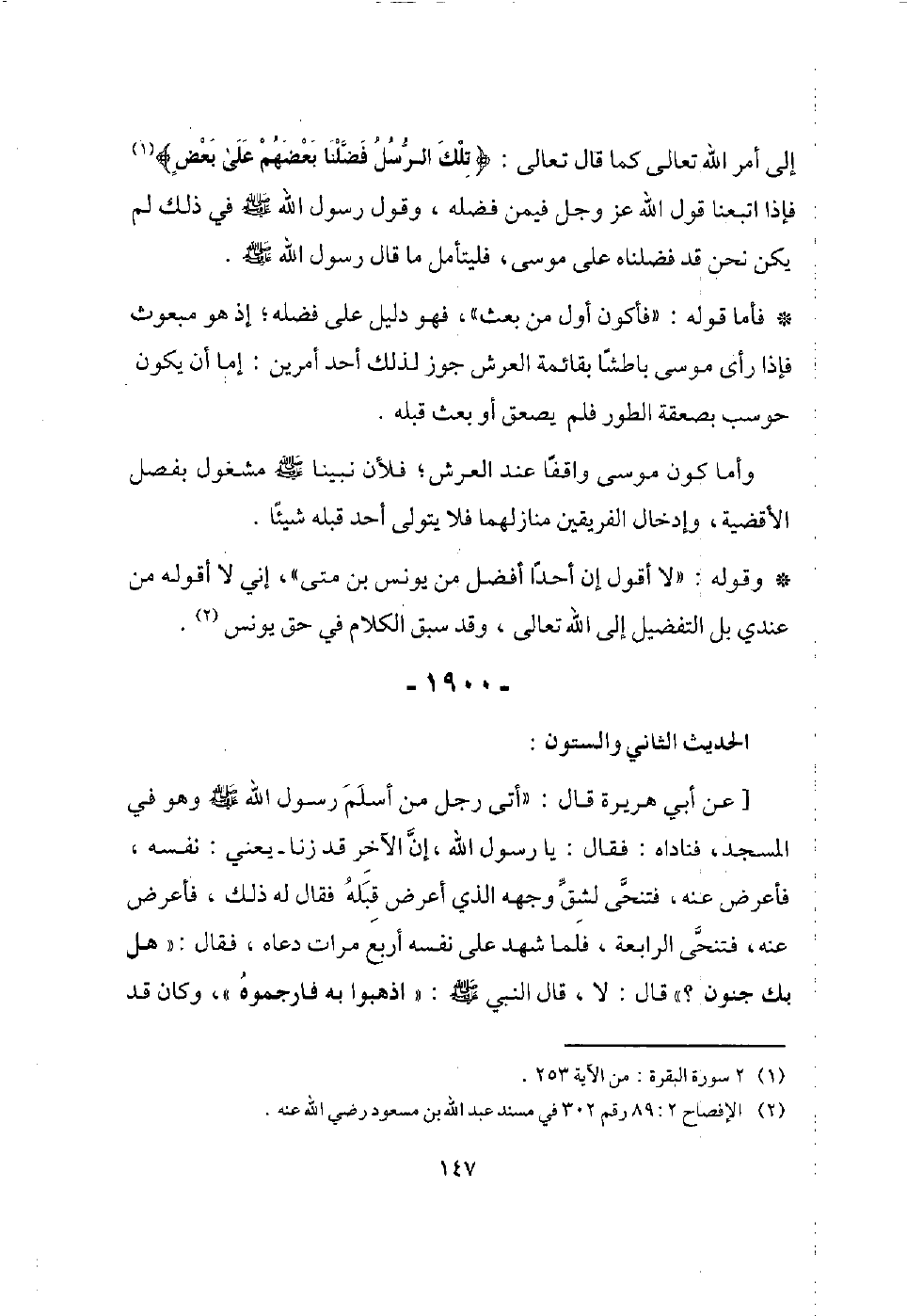
كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 6)
وهو فيها، وناشقًا من حثيث ريحها ما لم يسم كنه إلا بعد خروجه عنها، وواجدًا من لهبها ما لم يحسبه إلا بعد أن قل عنده وقعها؛ فكانت أمنيته من الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار، والله عز وجل قد علم منه أنه إذا صرف وجهه عنها سأل غير ذلك.وأراد سبحانه أن يعرفنا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهل هذا الرجل بربه، وأنه لم يكن من العلماء به جل جلاله؛ فإنه لما اشترط عليه أن لا يسأل ربه، استدل بذلك على أنه قد كان في الدنيا قل ما يسأل ربه، وإلا فقد كان من وفقه لو كان من أهل التوفيق، أن يقول: يا رب، وكيف لا أسألك؟ وأنت تحب أن تسأل؟ فمنذ قنع وشرط أن لا يسأل شيئًا دل بذلك على أنه كان من أهل عوائد السوء وقلة الطلب من الله عز وجل في دار الدنيا، ثم إنه لما رأى أنه لم يقدر أن يصبر على سؤال الله عز وجل؛ فاشترط عليه جل جلاله ثانيًا، لم (128/ أ) يتيقظ، ولم يقل: رب كيف لا أسألك وقد أريتني نعمة من نعمك فكم أصبر؟، وكيف أصبر على سؤال فضلك؟ وبماذا أستغني عنك، وممن أطلب إذا لم أطلب منك؟ وهل يمكن المؤمن في الدنيا أن يخلو طرفة عين من الطلب منك.
فلو قد عرف هذا الشخص معاملة الله عز وجل في الدنيا لما غم عليه هذا الأمر في الآخرة؛ فلما دناه إلى باب الجنة فانفهقت له، فرآها، طلب من الله أن يدخلها، فهذا لجهله لم يسأل الجنة إلا عند بابها بخلاف الموفقين من المؤمنين، فإنهم سألوا الجنة وبينهم وبينها مراحل الدنيا كلها، ومراحل البرزخ، ومراحل الآخرة على يقين بها، وهذا لم يعرف صفتها ولا طلبها حتى وصل إلى بابها بالرحمة، يدنيه منزلًا منزلًا، وجهله يبعده، ثم أن الله تعالى أدخله الجنة، وقال له: ما أغدرك؟ يجوز أن يكون المعنى أي شيء أغدرك، أي خلقك على أنه يفيق، فلم يفيق.