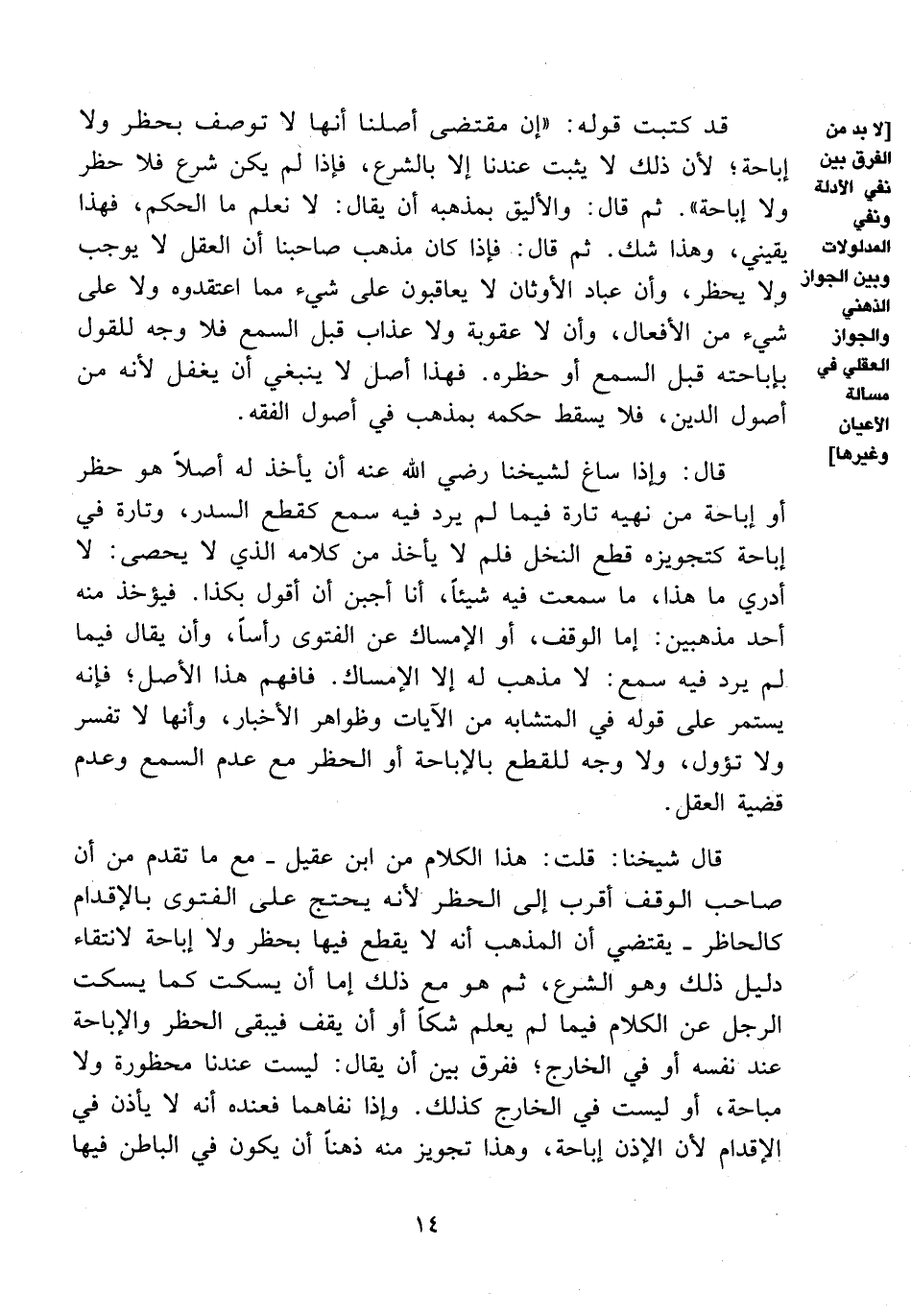
كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 2)
[لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]قد كتبت قوله: «إن مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لأن ذلك لا يثبت عندنا إلا بالشرع، فإذا لم يكن شرع فلا حظر ولا إباحة» ثم قال: والأليق بمذهبه أن يقال: لا نعلم ما الحكم، فهذا يقيني، وهذا شك. ثم قال: فإذا كان مذهب صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر، وأن عباد الأوثان لا يعاقبون على شيء مما اعتقدوه ولا على شيء من الأفعال، وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول بإباحته قبل السمع أو حظره. فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لأنه من أصول الدين، فلا يسقط حكمه بمذهب في أصول الفقه.
قال: وإذا ساغ لشيخنا رضي الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدر، وتارة في إباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا يأخذ من كلامه الذي لا يحصى: لا أدري ما هذا، ما سمعت فيه شيئا، أنا أجبن أن أقول بكذا. فيؤخذ منه أحد مذهبين: إما الوقف، أو الإمساك عن الفتوى رأسا، وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع: لا مذهب له إلا الإمساك. فافهم هذا الأصل؛ فإنه يستمر على قوله في المتشابه من الآيات وظواهر الأخبار، وأنها لا تفسر ولا تؤول، ولا وجه للقطع بالإباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل.
قال شيخنا: قلت: هذا الكلام من ابن عقيل -مع ما تقدم من أن صاحب الوقف أقرب إلى الحظر لأنه يحتج على الفتوى بالإقدام كالحاظر- يقتضي أن المذهب أنه لا يقطع فيها بحظر ولا إباحة لانتقاء دليل ذلك وهو الشرع، ثم هو مع ذلك إما أن يسكت كما يسكت الرجل عن الكلام فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقى الحظر والإباحة عند نفسه أو في الخارج؛ ففرق بين أن يقال: ليست عندنا محظورة ولا مباحة، أو ليست في الخارج كذلك. وإذا نفاهما فعنده أنه لا يأذن في الإقدام لأن الإذن إباحة، وهذا تجويز منه ذهنا أن يكون في الباطن فيها