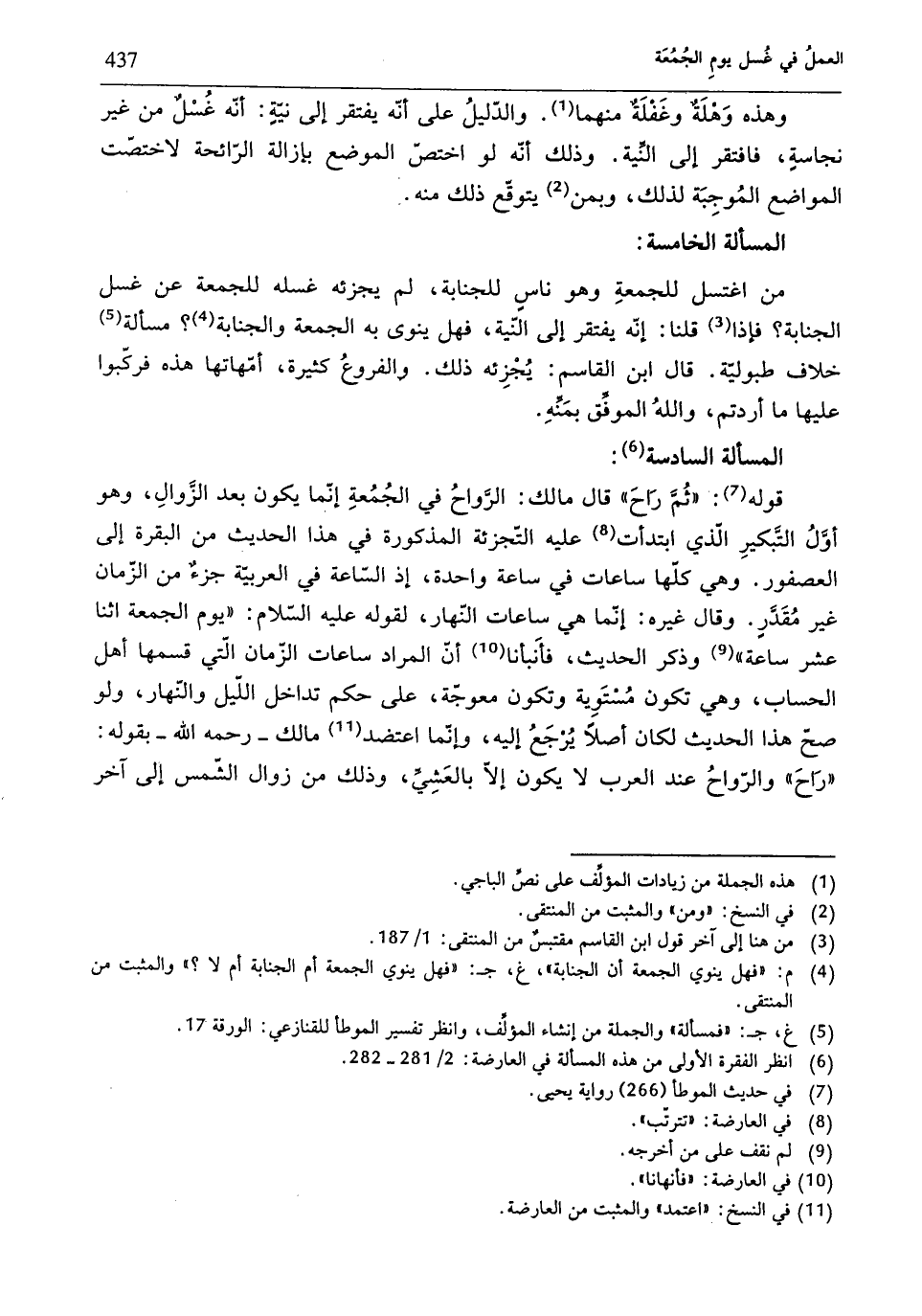
كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 2)
وهذه وَهْلَةٌ وغَفْلَةٌ منهما (¬1). والدّليلُ على أنّه يفتقر إلى نيّةٍ: أنّه غُسْلٌ من غير نجاسةٍ، فافتقر إلى النِّية. وذلك أنّه لو اختصّ الموضع بإزالة الرّائحة لاختصّت المواضع المُوجِبَة لذلك، وبمن (¬2) يتوقّع ذلك منه.المسألة الخامسة:
من اغتسل للجمعةِ وهو ناسٍ للجنابة، لم يجزئه غسله للجمعة عن غسل الجنابة؟ فهذا (¬3) قلنا: إنّه يفتقر إلى النّية، فهل ينوى به الجمعة والجنابة (¬4)؟ مسألة (¬5) خلاف طبوليّة. قال ابن القاسم: يُجْزِئه ذلك. والفروعُ كثيرة، أمّهاتها هذه فركّبوا عليها ما أردتم، واللهُ الموفِّق بمَنِّهِ.
المسألة السادسة (¬6):
قوله (¬7): "ثُمَّ رَاحَ" قال مالك: الرَّواحُ في الجُمُعةِ إنّما يكون بعد الزَّوالِ، وهو أوَّلُ التَّبكيرِ الّذي ابتدأت (¬8) عليه التّجزئة المذكورة في هذا الحديث من البقرة إلى العصفور. وهي كلّها ساعات في ساعة واحدة، إذ السّاعة في العربيّة جزءٌ من الزّمان غير مُقَدَّرِ. وقال غيره: إنّما هي ساعات النّهار، لقوله عليه السّلام: "يوم الجمعة اثنا عشر ساعة" (¬9) وذكر الحديث، فأَنبأنا (¬10) أنّ المراد ساعات الزّمان الّتي قسمها أهل الحساب، وهي تكون مُسْتَوِية وتكون معوجّة، على حكم تداخل اللّيل والنّهار، ولو صحّ هذا الحديث لكان أصلًا يُرْجَعُ إليه، وإنّما اعتضد (¬11) مالك - رحمه الله - بقوله: "راحَ " والرَّواحُ عند العرب لا يكون إلَّا بالعَشِىِّ، وذلك من زوال الشّمس إلى آخر
¬__________
(¬1) هذه الجملة من زيادات المؤلِّف على نصِّ الباجي.
(¬2) في النسخ: "ومن" والمثبت من المنتقى.
(¬3) من هنا إلى آخر قول ابن القاسم مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 187.
(¬4) م: "فهل ينوي الجمعة أنّ الجنابة"، غ، جـ: "فهل ينوي الجمعة أم الجنابة أم لا؟ " والمثبت من المنتقى.
(¬5) غ، جـ: "فمسألة" والجملة من إنشاء المؤلِّف، وانظر تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 17.
(¬6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 2/ 281 - 282.
(¬7) في حديث الموطَّأ (266) رواية يحيى.
(¬8) في العارضة: "تترتّب".
(¬9) لم نقف على من أخرجه.
(¬10) في العارضة: "فأنّهانا".
(¬11) في النسخ: "اعتمد" والمثبت من العارضة.