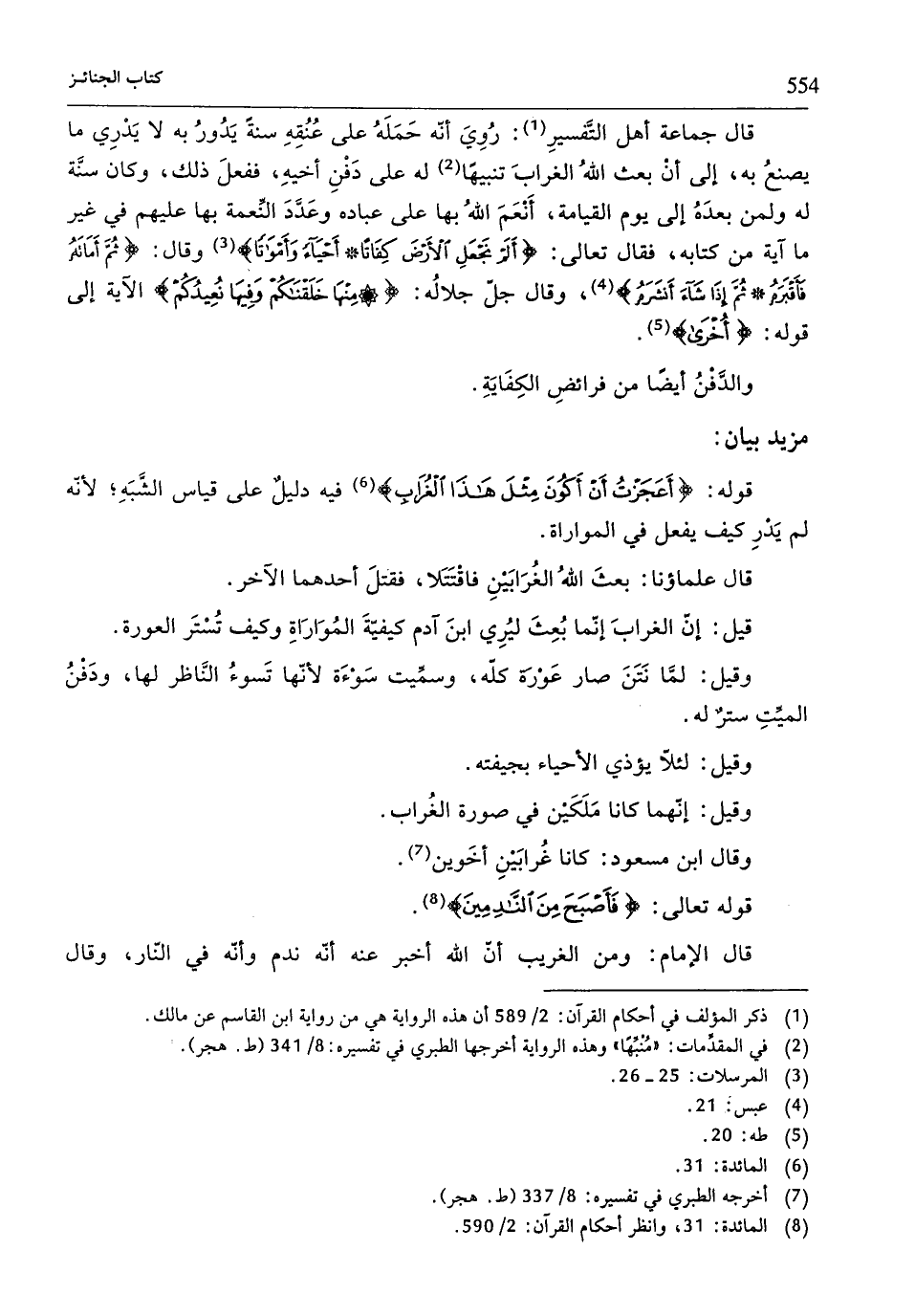
كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 3)
قال جماعة أهل التَّفسيرِ (¬1): رُوِيَ أنَّه حَمَلَهُ على عُنُقِهِ سنةً يَدُورُ به لا يَدْرِي ما يصنعُ به، إلى أنّ بعث اللهُ الغرابَ تنبيهًا (¬2) له على دَفْنِ أخيهِ، ففعلَ ذلك، وكان سنَّة له ولمن بعدَهُ إلى يوم القيامة، أَنْعَمَ اللهُ بها على عباده وعَدَّدَ النِّعمة بها عليهم في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (¬3) وقال: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} (¬4)، وقال جلَّ جلالُه: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} الآية إلى قوله: {أُخْرَى} (¬5).والدَّفْنُ أيضًا من فرائضِ الكِفَايَةِ.
مزيد بيان:
قوله: {أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ} (¬6) فيه دليلٌ على قياس الشَّبَهِ؛ لأنّه لم يَدْرِ كيف يفعل في المواراة.
قال علماؤنا: بعثَ اللهُ الغُرَابَيْنِ فاقتَتَلا، فقتلَ أحدهما الآخر.
قيل: إنّ الغرابَ إنّما بُعِثَ ليُرِي ابنَ آدم كيفيّةَ المُوَارَاةِ وكيف تُسْتَر العورة.
وقيل: لمَّا نَتَنَ صار عَوْرَة كلّه، وسمِّيت سَوْءَة لأنّها تَسوءُ النَّاظر لها، ودَفْنُ الميِّتِ سترٌ له.
وقيل: لئلّا يؤذي الأحياء بجيفته.
وقيل: إنّهما كانا مَلَكَيْن في صورة الغُراب.
وقال ابن مسعود: كانا غُرابَيْنِ أخَوين (¬7).
قوله تعالى: {فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (¬8).
قال الإمام: ومن الغريب أنّ الله أخبر عنه أنّه ندم وأنّه في النّار، وقال
¬__________
(¬1) ذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: 2/ 589 أنّ هذه الرِّواية هي من رواية ابن القاسم عن مالك.
(¬2) في المقدِّمات: "مُنبِّهًا" وهذه الرِّواية أخرجها الطّبريّ في تفسيره: 8/ 341 (ط. هجر).
(¬3) المرسلات: 25 - 26.
(¬4) عبس: 21.
(¬5) طه:20.
(¬6) المائدة: 31.
(¬7) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: 8/ 337 (ط. هجر).
(¬8) المائدة: 31، وانظر أحكام القرآن: 2/ 590.