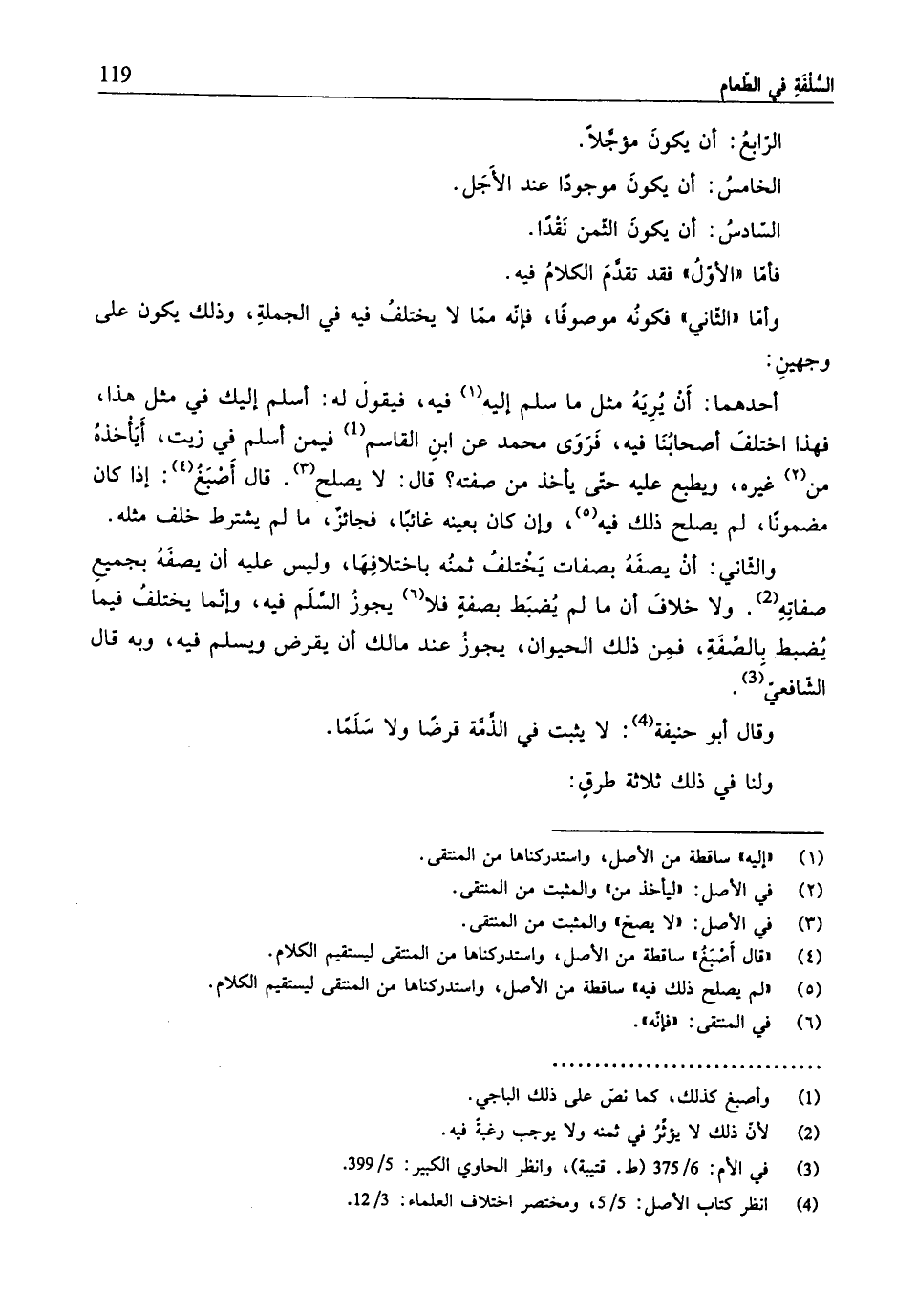
كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)
الرّابعُ: أنّ يكونَ مؤجَّلًا.الخامس: أنّ يكونَ موجودًا عند الأَجَل.
السّادسُ: أنّ يكونَ الثّمن نَقدًا.
فأمّا "الأوَّلُ" فقد تقدَّمَ الكلامُ فيه.
وأمّا "الثّاني" فكونُه موصوفًا، فإنّه ممّا لا يختلفُ فيه في الجملةِ، وذلك يكون على وجهينِ:
أحدهما: أَنْ يُرِيَهُ مثل ما سلم إليه فيه، فيقول له: أسلم إليك في مثل هذا، فهذا اختلفَ أصحابُنَا فيه، فَرَوَى محمّد عن ابنِ القاسم (¬1) فيمن أسلم في زيت، أَيَأخذهُ من غيره، ويطبع عليه حتّى يأخذ من صفته؟ قال: لا يصلح. قال أَصبغُ: إذا كان مضمونًا، لم يصلح ذلك فيه، وإن كان بعينه غائبًا، فجائزٌ، ما لم يشترط خلف مثله.
والثّاني: أنّ يصفَهُ بصفات يَختلف ثمنُه باختلافِهَا, وليس عليه أنّ يصفَهُ بجميعِ صفاتِهِ (¬2). ولا خلافَ أنّ ما لم يُضبَط بصفةٍ فلا يجوزُ السَّلَم فيه، وإنَّما يختلفُ فيما يُضبط بالصِّفَةِ، فمِن ذلك الحيوان، يجوزُ عند مالك أنّ يقرض ويسلم فيه، وبه قال الشّافعيّ (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4): لا يثبت في الذِّمَّة قرضًا ولا سَلَمًا.
ولنا في ذلك ثلاثة طرقٍ:
¬__________
(¬1) وأصبغ كذلك، كما نصّ على ذلك الباجي.
(¬2) لأنّ ذلك لا يؤثِّرُ في ثمنه ولا يوجب رغبةً فيه.
(¬3) في الأم: 6/ 375 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 5/ 399.
(¬4) انظركتاب الأصل: 5/ 5، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 12.