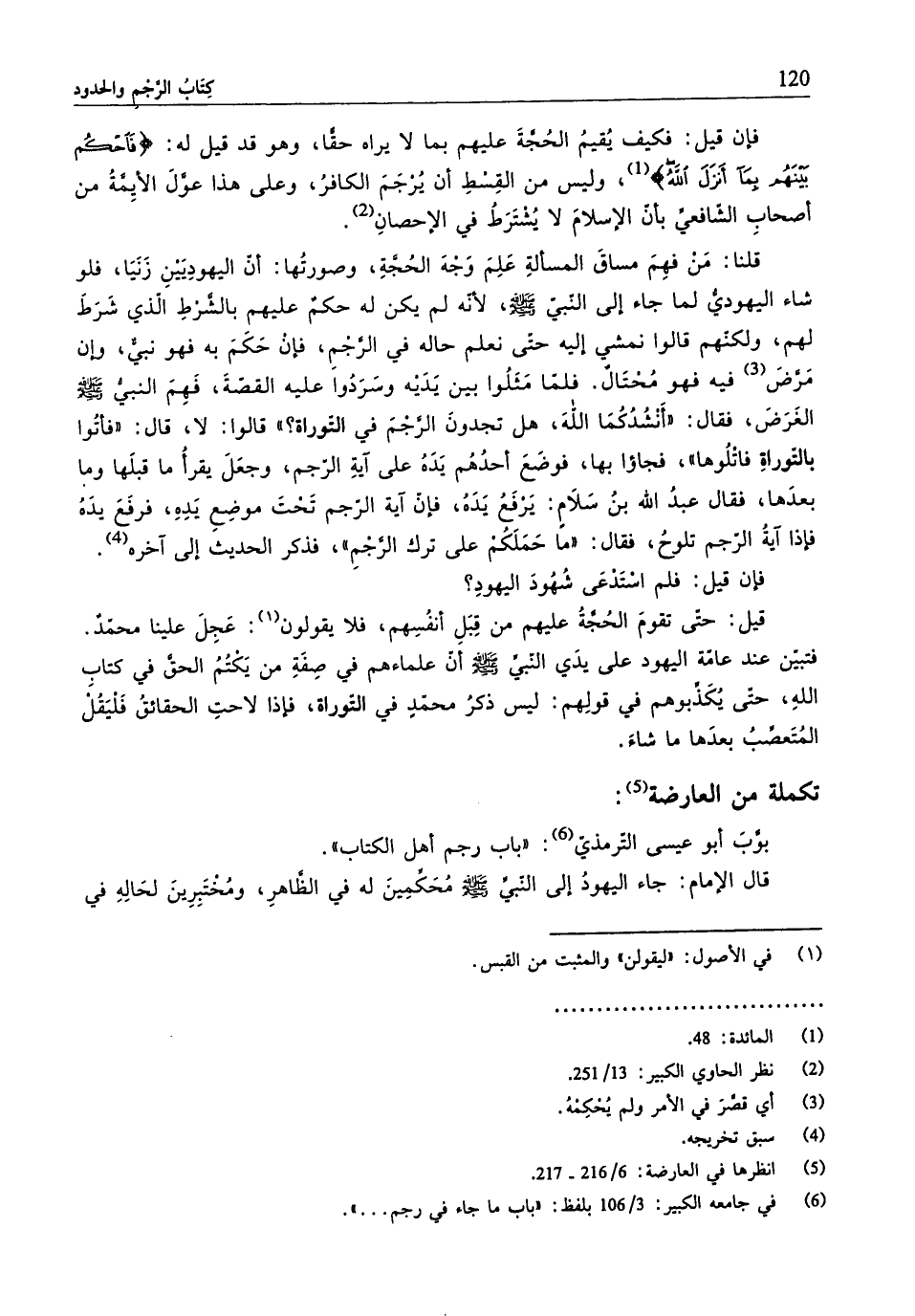
كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
فإن قيل: فكيف يُقيمُ الحُجَّةَ عليهم بما لا يراه حقًّا، وهو قد قيل له: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬1)، وليس من القِسطِ أنّ يُرجَمَ الكافرُ، وعلى هذا عوَّلَ الأيِمَّةُ من أصحابِ الشّافعيِّ بأنّ الإِسلامَ لا يُشتَرَطُ في الإحصانِ (¬2).قلنا: مَنْ فهِمَ مساقَ المسألةِ عَلِمَ وَجهَ الحُجَّةِ، وصورتُها: أنّ اليهودِيَينِ زَنَيَا، فلو شاء اليهوديُّ لما جاء إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، لأنّه لم يكن له حكمٌ عليهم بالشَّرطِ الّذي شَرَطَ لهم، ولكنّهم قالوا نمشي إليه حتّى نعلم حاله في الرَّجم، فإن حَكَمَ به فهو نبيٌّ، وإن مَرَّضَ (¬3) فيه فهو مُحتَالٌ. فلما مَثَلُوا بين يَدَيْه وسَرَدُوا عليه القصّةَ، فَهِمَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - الغَرَضَ، فقال: "أَنشُدُكُما الله، هل تجدونَ الرَّجْمَ في التّوراة؟ " قالوا: لا، قال: "فأتُوا بالتّوراةِ فاتلُوها"، فجاؤا بها، فوضَعَ أحدُهُم يَدَهُ على آيةِ الرّجم، وجعَلَ يقرأُ ما قبلَها وما بعدَها، فقال عبدُ الله بنُ سَلَامٍ: يَرفَعُ يَدَهُ، فإنّ آية الرَّجْم تَحتَ موضِعِ يَدِهِ، فرفَعَ يدَهُ فإذا آيةُ الرَّجْم تلوحُ، فقال: "ما حَمَلَكُم على ترك الرَّجم"، فذكر الحديث إلى آخره (¬4).
فإن قيل: فلم اسْتَدعَى شُهُودَ اليهودِ؟
قيل: حتّى تقومَ الحُجَّةُ عليهم من قِبَلِ أنفُسِهم، فلا يقولون: عَجِلَ علينا محمّدٌ. فتبيّن عند عامّة اليهود على يدَي النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّ علماءهم في صِفَةِ من يَكتُمُ الحقَّ في كتابِ اللهِ، حتّى يُكَذِّبوهم في قولِهم: ليس ذكرُ محمّدٍ في التّوراة، فإذا لاحتِ الحقائقُ فَليَقُل المُتَعصِّبُ بعدَها ما شاءَ.
تكملة من العارضة (¬5):
بوَّبَ أبو عيسى التّرمذيّ (¬6): "باب رجم أهل الكتاب".
قال الإمام: جاء اليهودُ إلى النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - مُحَكِّمِينَ له في الظَّاهرِ، ومُختَبِرِينَ لحَالِهِ في
¬__________
(¬1) المائدة: 48.
(¬2) نظر الحاوي الكبير: 13/ 251.
(¬3) أي قصَّرَ في الأمر ولم يُحكِمْهُ.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) انظرها في العارضة: 6/ 216 - 217.
(¬6) في جامعه الكبير: 3/ 106 بلفظ: "باب ما جاء في رجم ... ".