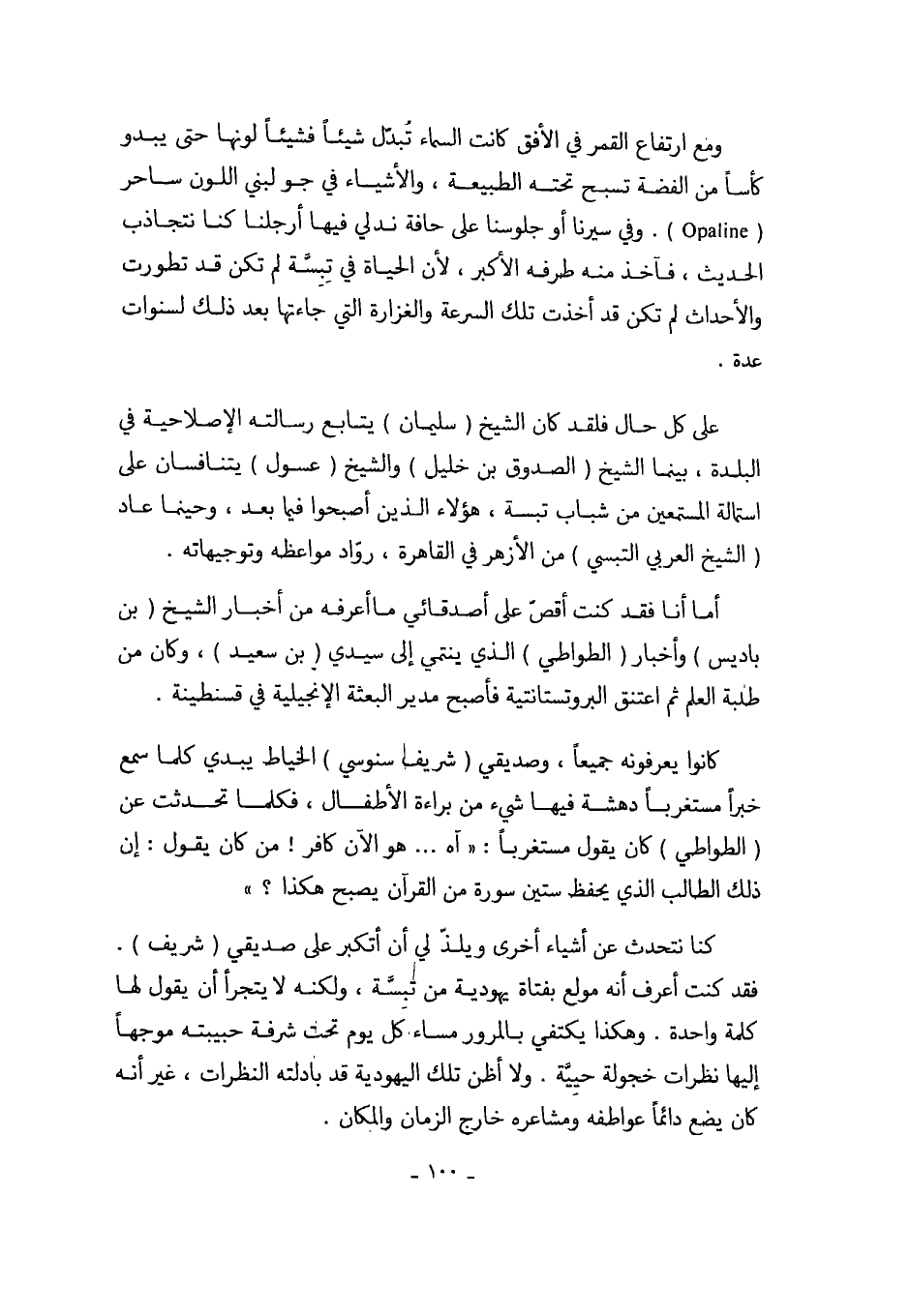
كتاب مذكرات شاهد للقرن
ومع ارتفاع القمر في الأفق كانت السماء تُبذل شيئاً فشيئاً لونها حتى يبدو كأساً من الفضة تسبح تحته الطبيعة، والأشياء في جو لبني اللون ساحر ( Opaline). وفي سيرنا أو جلوسنا على حافة ندلي فيها أرجلنا كنا نتجاذب الحديث، فآخذ منه طرفه الأكبر، لأن الحياة في تِبسَّة لم تكن قد تطورت والأحداث لم تكن قد أخذت تلك السرعة والغزارة التي جاءتها بعد ذلك لسنوات عدة.على كل حال فلقد كان الشيخ (سليمان) يتابع رسالته الإصلاحية في البلدة، بينما الشيخ (الصدوق بن خليل) والشيخ (عسول) يتنافسان على استمالة المستمعين من شباب تبسة، هؤلاء الذين أصبحوا فيما بعد، وحينما عاد (الشيخ العربي التبسي) من الأزهر في القاهرة، روّاد مواعظه وتوجيهاته.
أما أنا فقد كنت أقصّ على أصدقائي ما أعرفه من أخبار الشيخ (بن باديس) وأخبار (الطواطي) الذي ينتمي إلى سيدي (بن سعيد)، وكان من طلبة العلم ثم اعتنق البروتستانتية فأصبح مدير البعثة الإنجيلية في قسنطينة.
كانوا يعرفونه جميعاً، وصديقي (شريف سنوسي) الخياط يبدي كما سمع خبراً مستغرباً دهشة فيها شيء من براءة الأطفال، فكلما تحدثت عن (الطواطي) كان يقول مستغرباً: ((آه ... هو الآن كافر! من كان يقول: إن ذلك الطالب الذي يحفظ ستين سورة من القرآن يصبح هكذا؟))
كنا نتحدث عن أشياء أخرى ويلذّ لي أن أتكبر على صديقي (شريف). فقد كنت أعرف أنه مولع بفتاة يهودية من تبِسَّة، ولكنه لا يتجرأ أن يقول لها كلمة واحدة. وهكذا يكتفي بالمرور مساء كل يوم تحت شرفة حبيبته موجهاً إليها نظرات خجولة حيِيَّة. ولا أظن تلك اليهودية قد بادلته النظرات، غير أنه كان يضع دائماً عواطفه ومشاعره خارج الزمان والمكان.