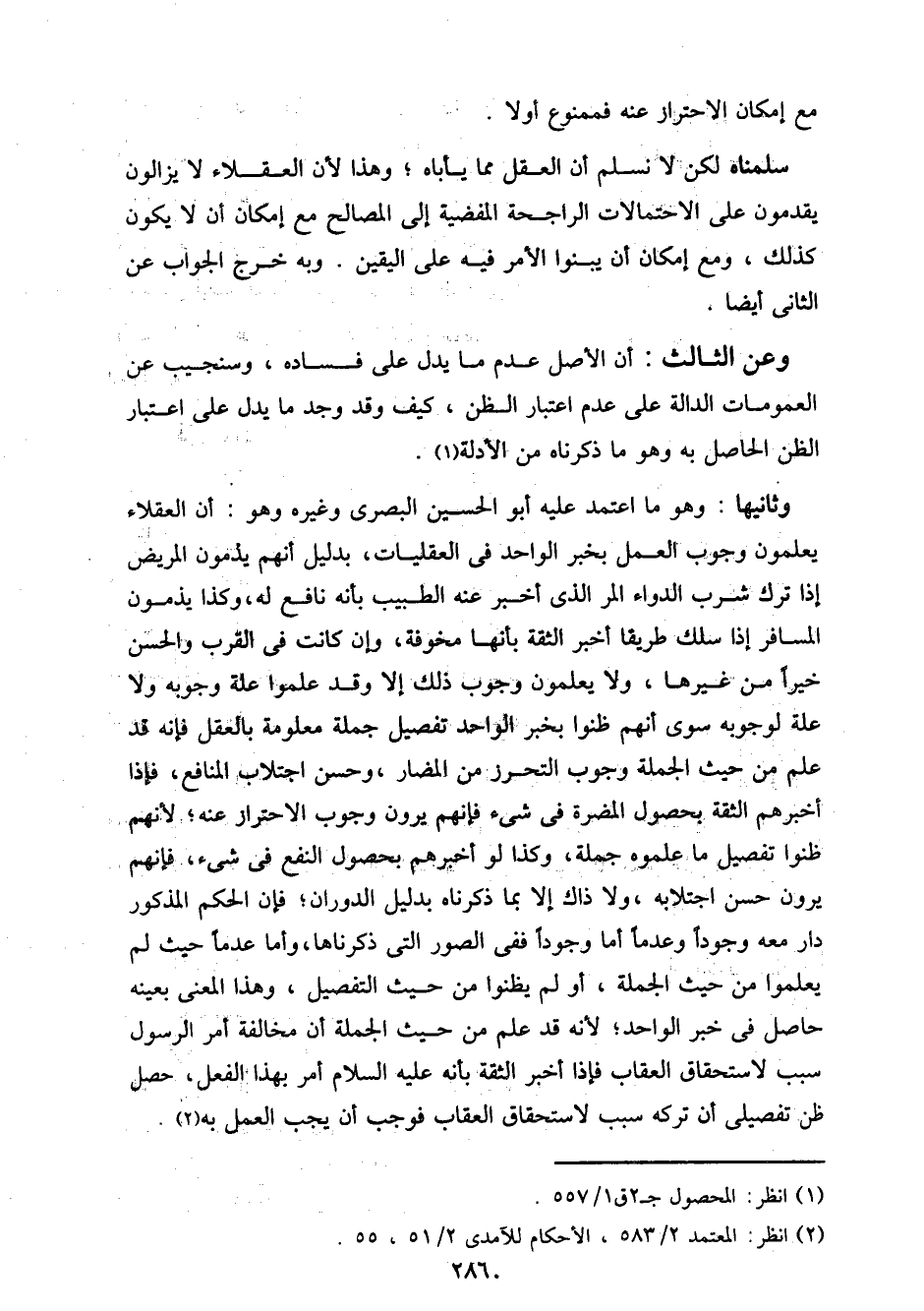
كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 7)
مع إمكان الاحتراز عنه فممنوع أولا.سلمناه لكن لا نسلم أن العقل مما يأباه؛ وهذا لأن العقلاء لا يزالون يقدمون على الاحتمالات الراجحة المفضية إلى المصالح مع إمكان أن لا يكون كذلك، ومع إمكان أن يبنوا الأمر فيه على اليقين. وبه خرج الجواب عن الثاني أيضا.
وعن الثالث: أن الأصل عدم ما يدل على فساده، وسنجيب عن العمومات الدالة على عدم اعتبار الظن، كيف وقد وجد ما يدل على اعتبار الظن الحاصل به وهو ما ذكرناه من الأدلة.
وثانيها: وهو ما اعتمد عليه أبو الحسين البصري وغيره وهو: أن العقلاء يعلمون وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات، بدليل أنهم يذمون المريض إذا ترك شرب الدواء المر الذي أخبر عنه الطبيب بأنه نافع له، وكذا يذمون المسافر إذا سلك طريقا أخبر الثقة بأنها مخوفة، وإن كانت في القرب والحسن خيرا من غيرها، ولا يعلمون وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه ولا علة لوجوبه سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل فإنه قد علم من حيث الجملة وجوب التحرز من المضار، وحسن اجتلاب المنافع، فإذا أخبرهم الثقة بحصول المضرة في شيء فإنهم يرون وجوب الاحتراز عنه؛ لأنهم ظنوا تفصيل ما علموه جملة، وكذا لو أخبرهم بحصول النفع في شيء، فإنهم يرون حسن اجتلابه، ولا ذاك إلا بما ذكرناه بدليل الدوران؛ فإن الحكم المذكور دار معه وجودا وعدما أما وجودا ففي الصور التي ذكرناها، وأما عدما حيث لم يعلموا من حيث الجملة، أو لم يظنوا من حيث التفصيل، وهذا المعنى بعينه حاصل في خبر الواحد؛ لأنه قد علم من حيث الجملة أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الثقة بأنه عليه السلام أمر بهذا الفعل، حصل ظن تفصيلي أن تركه سبب لاستحقاق العقاب فوجب أن يجب العمل به.