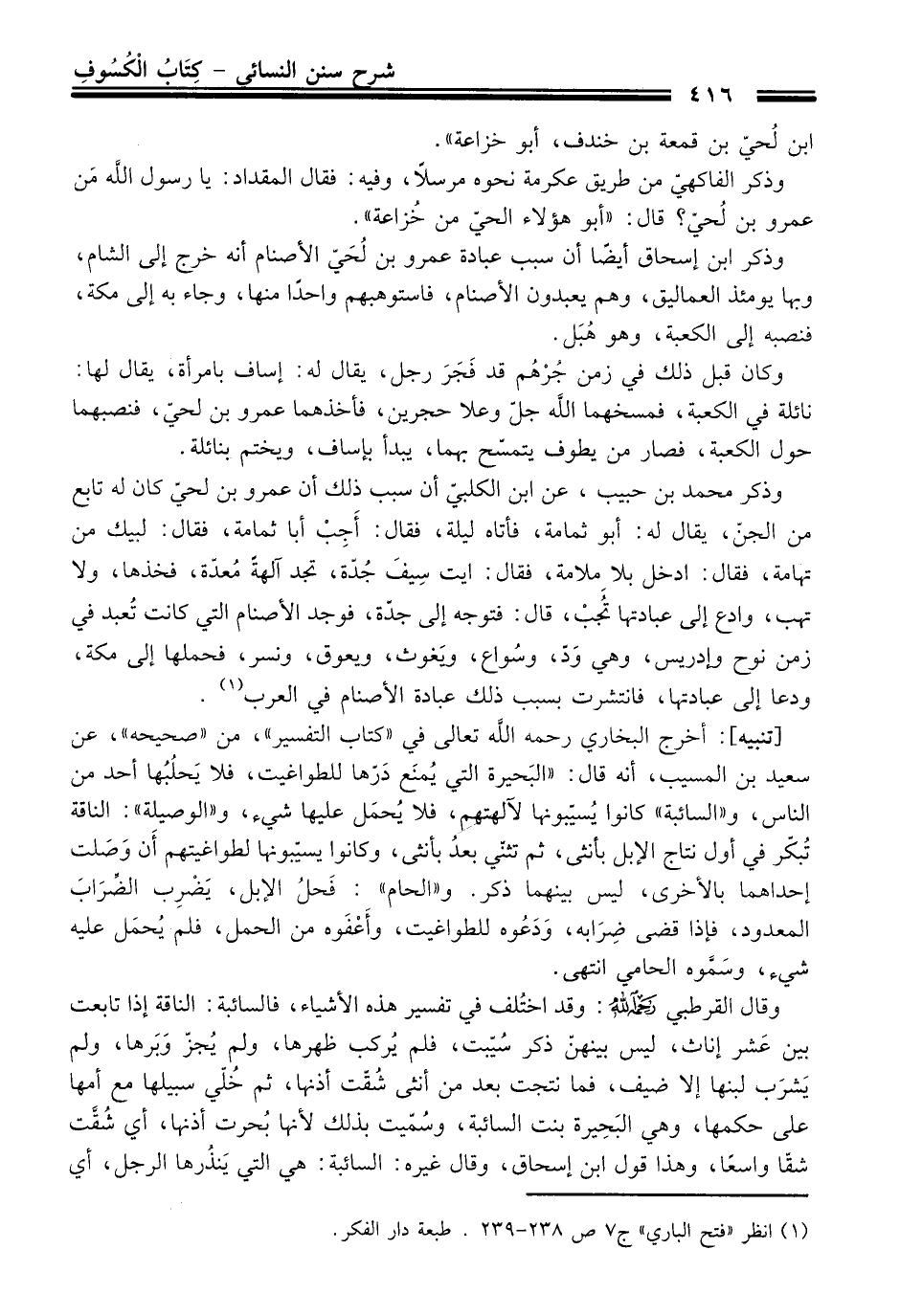
كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 16)
ابن لُحيّ بن قمعة بن خندف، أبو خزاعة".وذكر الفاكهيّ من طريق عكرمة نحوه مرسلًا، وفيه: فقال المقداد: يا رسول اللَّه مَن عمرو بن لُحيّ؟ قال: "أبو هؤلاء الحيّ من خُزاعة".
وذكر ابن إسحاق أيضًا أن سبب عبادة عمرو بن لُحَيّ الأصنام أنه خرج إلى الشام، وبها يومئذ العماليق، وهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم واحدًا منها، وجاء به إلى مكة، فنصبه إلى الكعبة، وهو هُبَل.
وكان قبل ذلك في زمن جُرْهُم قد فَجَرَ رجل، يقال له: إساف بامرأة، يقال لها: نائلة في الكعبة، فمسخهما اللَّه -جَلّ وَعَلاَ- حجرين، فأخذهما عمرو بن لحيّ، فنصبهما حول الكعبة، فصار من يطوف يتمسّح بهما، يبدأ بإساف، ويختم بنائلة.
وذكر محمد بن حبيب، عن ابن الكلبيّ أن سبب ذلك أن عمرو بن لحيّ كان له تابع من الجنّ، يقال له: أبو ثمامة، فأتاه ليلة، فقال: أَجِبْ أبا ثمامة، فقال: لبيك من تهامة، فقال: ادخل بلا ملامة، فقال: ايت سِيفَ جُدّة، تجد آلهةَ مُعدّة، فخذها، ولا تهب، وادع إلى عبادتها تُجَبْ، قال: فتوجه إلى جدّة، فوجد الأصنام التي كانت تُعبد في زمن نوح وإدريس، وهي وَدّ، وسُواع، وَيغوث، ويعوق، ونسر، فحملها إلى مكة، ودعا إلى عبادتها، فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب (¬1).
[تنبيه]: أخرج البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب التفسير"، من "صحيحه"، عن
سعيد بن المسيب، أنه قال: "البَحيرة التي يُمنَع دَرّها للطواغيت، فلا يَحلُبُها أحد من الناس، و"السائبة" كانوا يُسيّبونها لآلهتهِم، فلا يُحمَل عليها شيء، و"الوصيلة": الناقة تُبكّر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثنّي بعدُ بأنثى، وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أَن وَصَلت إحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذكر. و"الحام": فَحلُ الإبل، يَضْرِب الضِّرَابَ
المعدود، فإذا قضى ضِرَابه، وَدَعُوه للطواغيت، وأَعْفَوه من الحمل، فلم يُحمَل عليه شيء، وسَمَّوه الحامي انتهى.
وقال القرطبي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقد اختُلف في تفسير هذه الأشياء، فالسائبة: الناقة إذا تابعت بين عَشر إناث، ليس بينهنّ ذكر سُيّبت، فلم يُركب ظهرها، ولم يُجرّ وَبَرها، ولم يَشرَب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد من أنثى شُقّت أذنها، ثم خُلّي سبيلها مع أمها على حكمها، وهي البَحِيرة بنت السائبة، وسُمّيت بذلك لأنها بُحرت أذنها، أي شُقَّت شقًا واسعًا، وهذا قول ابن إسحاق، وقال غيره: السائبة: هي التي يَنذُرها الرجل، أي
¬__________
(¬1) انظر "فتح الباري" ج 7 ص 238 - 239. طبعة دار الفكر.