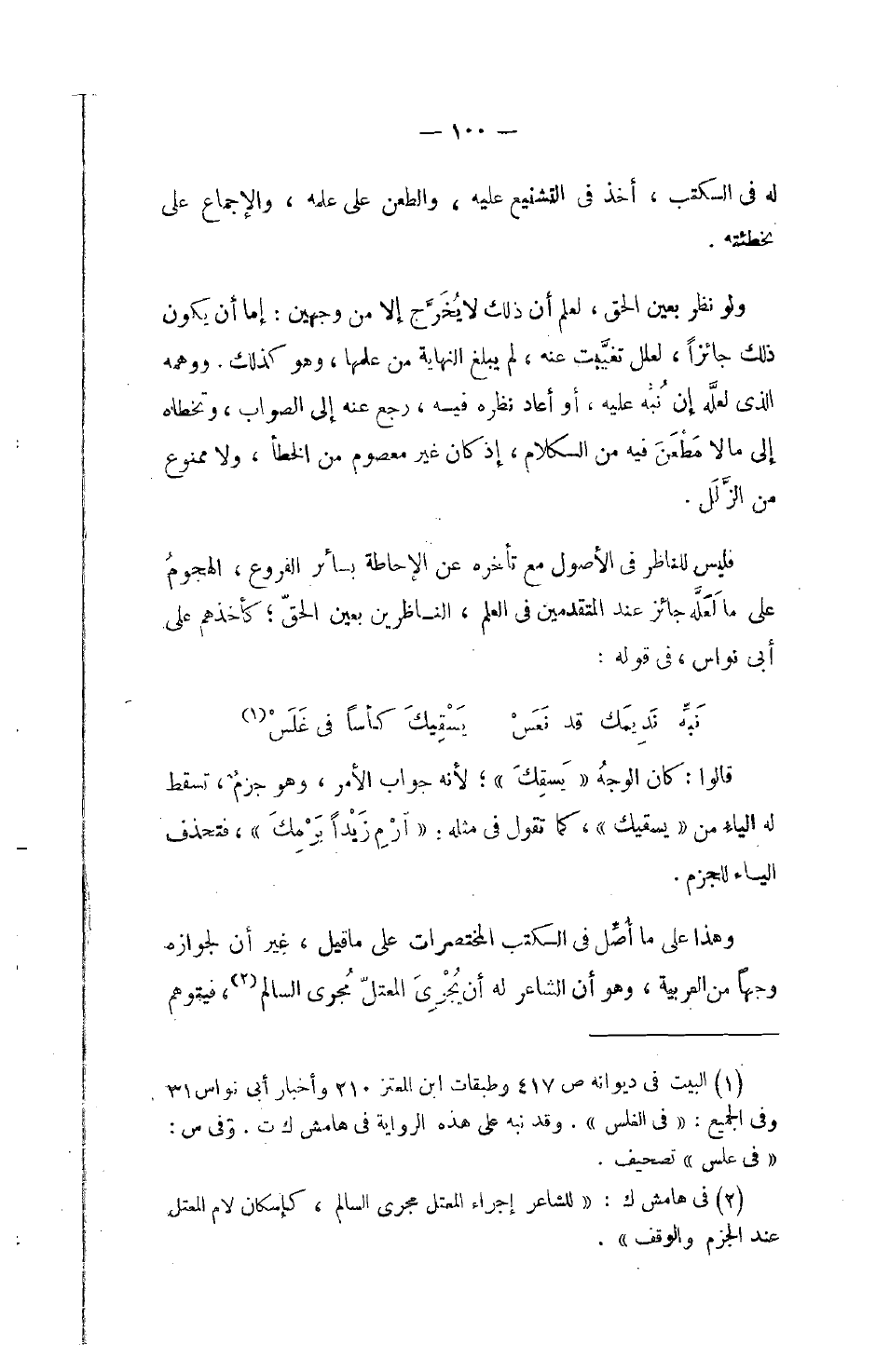
كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة
له في الكتب، أخذ في التشنيع عليه، والطعن على علمه، والإجماع على تخطئته.ولو نظر بعين الحق، لعلم أن ذلك لا يُخَرَّج إلا من وجهين: إما أن يكون ذلك جائزاً، لعلل تغيَّبت عنه، لم يبلغ النهاية من علمها، وهو كذلك، ووهمه الذي لعلَّه إن نُبِّه عليه، أو أعاد نظره فيه، رجع عنه إلى الصواب، وتخطاه إلى مالا مَطْعَنَ فيه من الكلام، إذ كان غير معصوم من الخطأ، ولا ممنوع من الزَّلَل.
فليس للناظر في الأصول مع تأخره عن الإحاطة بسائر الفروع، الهجومُ على ما لَعلَّه جائز عند المتقدمين في العلم، الناظرين بعين الحقّ؛ كأخذهم على أبي نواس، في قوله:
نَبِّه نَدِيمَك قد نَعَسْ ... يَسْقيكَ كأساً في غَلَسْ
قالوا: كان الوجهُ يَسْقِكَ؛ لأنه جواب الأمر، وهو جزمٌ، تسقط له الباءُ من يسقيك، كما تقول في مثله: ارْمِ زَيْداً يَرْمِك، فتحذف الياء للجزم.
وهذا على ما أُصِّل في الكتب المختصرات على ما قيل، غير أن لجوازه وجهاً من العربية، وهو أن الشاعر له أن يُجْرِيَ المعتلّ مُجرى السالم، فيتوهم