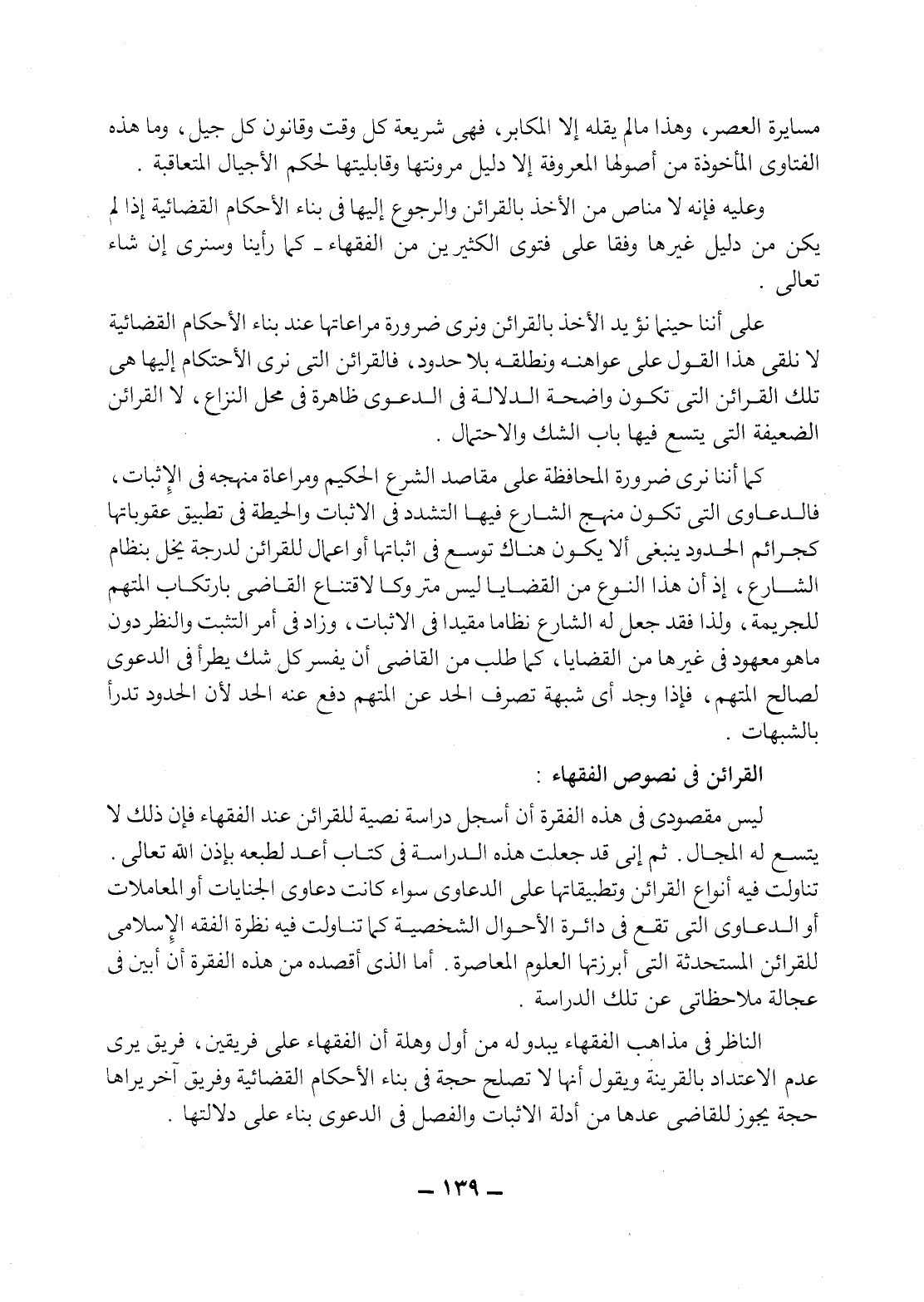
كتاب نظام الإثبات في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 62)
مسايرة العصر، وهذا ما لم يقله إلا المكابر، فهي شريعة كل وقت وقانون كل جيل، وما هذه الفتاوى المأخوذة من أصولها المعروفة إلا دليل مرونتها وقابليتها لحكم الأجيال المتعاقبة.وعليه فإنه لا مناص من الأخذ بالقرائن والرجوع إليها في بناء الأحكام القضائية إذا لم يكن من دليل غيرها وفقاً على فتوى الكثيرين من الفقهاء -كما رأينا وسنرى إن شاء تعالى-.
على أننا حينما نؤيد الأخذ بالقرائن ونرى ضرورة مراعاتها عند بناء الأحكام القضائية لا نلقي هذا القول على عواهنه ونطلقه بلا حدود، فالقرائن التي نرى الاحتكام إليها هي تلك القرائن التي تكون واضحة الدلالة في الدعوى ظاهرة في محل النزاع، لا القرائن الضعيفة التي يتسع فيها باب الشك والاحتمال.
كما أننا نرى ضرورة المحافظة على مقاصد الشرع الحكيم ومراعاة منهجه في الإثبات، فالدعاوى التي تكون منهج الشارع فيها التشدد في الإثبات والحيطة في تطبيق عقوباتها كجرائم الحدود ينبغي ألا يكون هناك توسّع في إثباتها أو إعمال للقرائن لدرجة يخل بنظام الشارع، إذ أن هذا النوع من القضايا ليس متروكا لاقتناع القاضي بارتكاب المتهم للجريمة، ولذا فقد جعل له الشارع نظاما مقيَّدا في الإثبات، وزاد في أمر التثبت والنظر دون ما هو معهود في غيرها من القضايا، كما طلب من القاضي أن يفسر كل شك يطرأ في الدعوى لصالح المتهم، فإذا وجد أي شبهة تصرف الحد عن المتهم دفع عنه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
القرائن في نصوص الفقهاء:
ليس مقصودي في هذه الفقرة أن أسجِّل دراسة نصِّية للقرائن عند الفقهاء فإن ذلك لا يتسع له المجال. ثم إني قد جعلت هذه الدراسة في كتاب أعدّ لطبعه بإذن الله تعالى. تناولت فيه أنواع القرائن وتطبيقاتها على الدعاوى سواء كانت دعاوى الجنايات أو المعاملات أو الدعاوى التي تقع في دائرة الأحوال الشخصية كما تناولت فيه نظرة الفقه الإسلامي للقرائن المستحدثة التي أبرزتها العلوم المعاصرة. أما الذي أقصده من هذه الفقرة أن أبيِّن في عجالة ملاحظاتي عن تلك الدراسة.
الناظر في مذاهب الفقهاء يبدو له من أولى وهلة أن الفقهاء على فريقين، فريق يرى عدم الاعتداد بالقرينة ويقول إنها لا تصلح حجة في بناء الأحكام القضائية, وفريق آخر يراها حجة يجوز للقاضي عدها من أدلة الإثبات والفصل في الدعوى بناء على دلالتها.